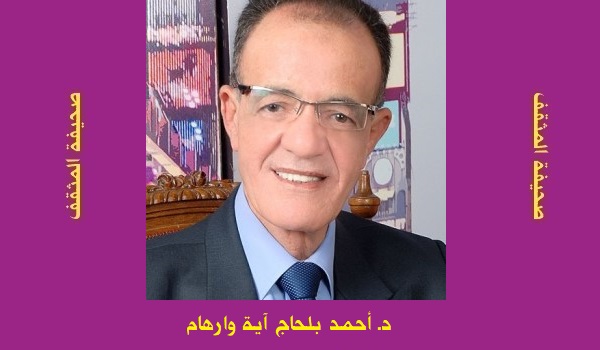أقلام فكرية
المنطق بين الصورية والمادية (2)
أولا: ضبط المشكلة: إن من أهم المسائل التي تثار حول طبيعة المنطق هي مسألة طبيعته من حيث الصورية والمادية. هل المنطق يختص بصورة الفكر وبالتالي فهو صوري، أم يختص بالأشياء في ذاتها ومضمونها المادي وبالتالي فهو مادي؟
يقول المنطقي الانجليزي جونسون:" إن المنطق يحاول تحليل ونقد الفكر، وهذا التحليل قد يتعلق بالفكر نفسه أو بمبادئه وصوره، وقد يتعلق بمضمون الفكر أو بمحتواه"(74). لقد كانت هذه هي المشكلة التي واجهت الباحثين في المنطق. والتي على أساسها قسم المناطقة المنطق إلى قسمين منطق صوري، ومنطق مادي. الأول يبحث في صورية الفكر فقط، بغض النظر عن الموضوعات التي يبحث فيها، والثاني يهتم بالناحية الموضوعية للفكر أي الأشياء. ولهذا كان موضوع المنطق الصوري هو البحث في القواعد التي تجعل الفكر متفقا مع ذاته؛ عدم تناقض الفكر مع القواعد التي وضعها بذاته. يبحث فقط في القواعد والشروط التي تضمن لنا الانتقال من المقدمات إلى النتائج دون تناقض. هذه القواعد والشروط صورية خالصة ولا علاقة لها بمضمون الفكر أو الواقع المادي الموضوعي. فقط ينبغي أن نميز هنا بين صورة الفكر والفكر كفعل وهو موضع لعلم النفس، ولا علاقة للمنطق بـذلك. ومن هنا فعمل المنطق الصوري هو أن يقدم لنا القواعد التي تجعل استدلالنا صحيحا من الناحية المنطقية(75).
أمــا موضوع المنطـــق المـادي فهو وضع القواعـد الـــتي تجعـل الفكـر متطابقـا مع الواقـع (الأشياء) أي أن تعبـر في الذهـن علـى مـا هـي عليـه في الخـارج.
فإذا قلنا مثلا "إذا سقط المطر ابتلت الأرض".، ونظرنا إلى القضية من الناحية الصورية لا نبحثها إلا من حيث لزوم التالي عن المقدم وصحة الارتباط، أما إذا كان المقصود هو صحة هذه القضية من حيث الواقع فهذا شيء آخر، يستلزم منا البحث في مادة القضية ومضمونها. هل تنطبق على الواقع أم لا؟ هل هي تنطبق على شيء خارجي أم هي مجرد افتراض ذهني؟ نلاحظ أن هناك اختلاف واضح أن نبحث القضية من حيث صورتها فقط وأن نبحثها من حيث مضمونها.
اختلف المناطقة حول هذه المسألة فمنهم من ذهب إلى أن المنطق صوري، لا يبحث إلا في صورة الفكر، أي في قوانين عامة تنطبق على التفكير المجرد بصفة مطلقة، وأن البحث في الجانب المادي أو مضمون الفكر ليس منطقا وإنما هو بحث يرتبط بفلسفة العلوم أو علم المناهج. فعمل المنطق هو البحث في المبادئ العامة للفكر أيا كان موضوعه، ولهذا فالمنطق يستبعد كل اعتبار لمادة الفكر. فهو صوري خالص(76). لم يوافق التجريبيون على هذا بل ذهبوا إلى أنه لا يمكن الفصل بين الفكر والمادة فهما شيء واحد يكوّن المنطق، فالفكر عيني، مادي وليس هناك فكر مجرد. وعلى أساس هذا التقسيم أصبح المنطق الصوري محصورا في نظرية القياس وبعض لواحقها، ويكون المنطق المادي يشمل الاستدلال الاستقرائي وغيره من صور الاستدلال الحديثة. قبل اتخاذ مقاربة من هذه المشكلة ينبغي الرجوع بها إلى واضع المنطق نفسه أرسطو، ثم من جاء بعده حتى العصر المعاصر.
ثانيا: موقف أرسطو من صورية المنطق وماديته
لقد نظر أرسطو إلى التصورات على أنها متسلسلة في الذهن بطريقة معينة تخضع لقواعد عامة يسير عليها العقل، وهو يربط بين هذه التصورات بغض النظر عما تشير إليه هذه التصورات من واقع خارجي خاضع للتجربة؛ فهذه التصورات تترابط لتكون القضايا، وهذه الأخيرة تكون حملية أو شرطية، ولكل منهما صورته وقواعده العقلية العامة.
وإذا ما انتقلنا إلى ربط هذه القضايا فإننا نجد أنفسنا أمام القياس الأرسطي، وهو بدوره له شروطه، وقواعده، وصوره التي تشكل منها وقالبه بصفة عامة هو المقدمتين والنتيجة.
وهذا ما يجعلنا نقرر على حد تعبير علي عبد المعطي أن المنطق الأرسطي كان منطقا صوريا إلى حد كبير، لا يهتم بتطابق الفكر مع الواقع بقدر ما يهتم ببيان القواعد العامة التي يسير بمقتضاها الفكر وهو يربط التصورات في قضايا ثم يربط القضايا في أقيسة. ويواصل عبد المعطي بقوله ومع هذا فنحن لا نستطيع أن نجزم بأن المنطق عند أرسطو كان صوريا خالصا، وإن كانت هذه غاية أرسطو في تحليلاته الأولى. إلا أنه في تحليلاته الثانية يتحدث عما يسمى الآن بمناهج البحث في العلوم، أو بمعنى آخر، يتحدث عن الاستدلال من حيث انطباقه على موضوع العلم. وهذا ما يرجع بنا إلى المنطق المادي الذي يهتم بانطباق الفكر مع الواقع(77).
ويذهب النشار إلى أنه من المؤكد أن المنطق عند أرسطو لم يكن شكليا بحتا، فنحن نستطيع أن نجد عنده نوعين من أنواع المنطق: المنطق الصغير وهو دراسة قوانين الفكر خالصة ومجردة من كل مضمون، وهذا ما هو متعارف عليه الآن بالمنطق الضيق (نظرية القياس) وهو ما بحثه أرسطو في ما سماه بالتحليلات الأولى. والمنطق الكبير، وهو ينطبق على مناهج البحث، وهو دراسة عمليات العقل منطبقة على هذا العلم أو ذاك وهو ما بحثه أرسطو في ما سماه بالتحليلات الثانية(78). أو ما يسمى بالبرهان. وينتهي النشار من هذا التحليل إلى أن المنطق عند أرسطو لم يكن صوريا بحتا وإن كان الجزء الأكبر منه تغلب فيه الناحية الشكلية. بل أن التحليلات الأولى والتي تعتبر بأنها صورية وشكلية، فيها جانب مادي بدليل أن هناك من يذهب إلى أن أرسطو وصل إلى الكثير من قواعد القياس وإلى المقولات نفسها بواسطة تحليل مادي(79).
وكان أرسطو يوصف بأنه ذو نزعة واقعية يقول أبو يعرب المرزوقي:" فرغم أن الواقعية الصورية المفارقة للرياضي تبدو، مغايرة تمام المغايرة للواقعية الصورية المحايثة، إلا أن مجال تحديد الرياضي بالإضافة إلى الطبيعي يبقى واحدا عند أفلاطون وأرسطو. فكلاهما يحدده بما ينسبه إليه من حضور في الطبيعي؛ ومن ثم فهما يعترفان له بالواقعية، أعني بالوجود والقيام الذاتي.." (80).
وقد سبق وأن بيّنا في الفصل الأول كيف أن المناطقة المسلمين قد فهموا هذا التوجه عند أرسطو، ومنهم الشيخ الرئيس ابن سينا: الذي كان يرى أنه إذا كان المنطق يمدنا بقواعد تعصمنا من الخطأ، فهو صوري ومادي في الوقت نفسه. فإذا كان هذا الفكر يتجه نحو صورة الفكر، فإنه يتجه كذلك نحو مادته، وأنه إذا كان أرسطو شكليا في التحليلات الأولى، فإنه مادي في بحثه عن البرهان، بل يحاول أن يطبق هذه القوانين الصورية في كثير من كتبه الأخرى، التي اعتبرها مفكرو الإسلام جزء من المنطق (كالجدل والأغاليط والخطابة والشعر)، فهو لا يبحث في هذه المؤلفات في صورة الفكر فقط بل يبحث أيضا في مادته(81). غير أن المناطقة المسلمين المتأخرين اعتبروا المنطق صوريا فحسب وحصروه في مبحثين مبحث التصورات ومبحث التصديقات. يقول ابن خلدون:" ثم جاء المتأخرون فغيروا اصطلاح المنطق" وإن من هذا التغيير تكلمهم في القياس من حيث إنتاجه للمطالب على العموم لا بحسب مادته وحذفوا النظر فيه بحسب المادة"(82).
أما السبب الذي جعل أرسطو ينظر إلى المنطق على أنه صوري ومادي في الآن نفسه إنما يتضح بالعودة إلى مصادر هذا المنطق والبيئة التي نشأ فيها والتي فصلناها في الفصل الأول. ويذهب النشار أيضا إلى أن هناك أبحاث كثيرة في عصرنا بحثت الجانب المادي في المنطق الأرسطي وأنه مجرد تجريد لأسس فيزيقية بحثها أرسطو، وانتهى منها إلى وضع منطقه الصوري(83).
لكن تحت تأثير الشراح وخاصة شراح العصور الوسطى (المتأخرين منهم) فهم المنطق الأرسطي على أنه منطق صوري بحت.
يقول تريكو في هذا الصدد:" إن العصور الوسطى كانت العهد الذهبي للمنطق الأرسطي الشكلي بكل معانيه الشكلية وقد عمقت من هذه المنطق وذهبت به إلى النهاية في الصورية وأقاموه على النظرة الماصدقية وتركوا النظرة المفهومية التي يقوم عليها القياس" وأبرز المنطقيين حسب تريكو في هذا العصر بالذات وأبعدهم عن الواقع هو ريمون لول Raymond LULL(84).
يقول النشار:" عرف المدرسيون المنطق الأرسطي معرفة كاملة، ولكن فكرة أرسطو عن المنطق لم تؤخذ عندهم أخذا كاملا فقد اعتبروا المنطق صوريا بحتا، وعلما متمايزا منبثقا عن ذاته منفصلا... عن الواقع... وغارقا في ميكانيكية بحتة ومنتهيا إلى استدلال وبرهنة جوفاء"(85). وبدأت الثورة على هذا المنطق الشكلي العقيم الذي لا يرتبط بالواقع كما وصفوه في عصر النهضة."
فقد هاجم (راموس Ramus) الأورغانون فأفسد نظرية القياس من أصولها، ووضع (بيكون Bacon) أورغانونه الجديد الذي يقوم على التجربة وتصور منطقا استقرائيا بعيدا عن روح أرسطو". وأتم ديكارت هزيمة أرسطو. وأسس العلم الحديث فحولت الكيفية إلى الكمية على حد تعبير تريكو(86). وصارت الرياضيات هي المنطق الحقيقي لما تتميز به من دقة لغة ومنهجا. وفي العصر الحديث دأب جل المناطقة على اعتبار المنطق صوري ومادي معا. يذهب كينز بعد التساؤل حول صورية المنطق وماديته هل المنطق صوري أم مادي؟ ذاتي أم موضوعي؟ يتعلق بالفكر وتناسقه الذاتي أم يتعلق بالأشياء؟ فيجيب قائلا:" إنه من المعتاد أن نقول أن المنطق صوري يهتم فقط بصورة الفكر أي بطريقتنا في التفكير المبتعدة عن الموضوعات المشخصة التي نفكر فيها، كما أنه من المعتاد أيضا أن نقول أن المنطق مادي من حيث أنــه يشير إلى الموضوعات المختلفة التي نفكـــر فيها.
ويقرر بعد ذلك أن المنطق صوري من جهة، ذلك أنه لا يتناول وقائع مادية، كما أن الاستدلال فيه يكون له نمط معين أو صورة محددة، كما أن الموضوعات الرئيسية في المنطق ليست إلا محاولة للكشف عن أكثر الأنماط أو الصور دقة والتي يمكن رد كل استدلالاتنا إليها- وينتهي إلى أن المنطق مادي من حيث أنه يشبع فضولنا بواسطة ملأ هذه الصور المنطقية بمادة موضوعية مستمدة من العالم الخارجي. ومن هنا فالمنطق عند كينز صوري ومادي في الآن عينه(87).
ويرى لاتا وماكبث، أن الفكر يرتبط دائما بموضوع، وأنه يكون متصلا باستمرار بموضوعاته، وأنه لا يوجد فكر مجرد تماما، فالفكر ليس منفصلا عن الموضوعات أو إطارا مستقلا عنها، رغم أننا نستطيع أن نميز بين الفكر وبين موضوعاته، ففي الطبيعيات نحن نفكر في المادة والطاقة، وفي البيولوجيا نفكر في الحيات، وفي علم النفس نفكر في العمليات العقلية والنفسية الداخلية، وفكرنا يختلف من علم إلى آخر منهجا وإطارا بحسب اختلاف موضوعات هذه العلوم. الأمر نفسه ينطبق على المنطق، فهو يبحث في الصور الفكرية الملائمة لموضوعاته(88). وهذا ما عبر عنه كينز في قوله:" إن العلوم كلها صورية من حيث أنها تجرد الصور من الموضوعات... وأن المنطق هو أكثر هذه العلوم تجريدا وتعميما وصورية"(89). ونفهم من هذا أن العلوم لا تختلف عن بعضها البعض إلا في درجة الصورية أي أن بعضها أكثر صورية من الآخر.
ولعل هذا ما عبر عنه بوزنكيت حين ذهب إلى أن المادة لا توجد بدون صورة، وأن العلوم تتجه بأكملها إلى البحث عن تلك الصورة التي قلنا أنها ترتبط بالمادة، ويخلص بوزنكيت إلى أن كل العلوم صورية، وأن المنطق علم صوري وأن الهندسة علم صوري وحتى الفيزيقا علوم صورية، فكل العلوم صورية لأنها تتعقب الخصائص والصور الكلية للأشياء(90).
إلا أن العلوم عند بوزنكيت تختلف في درجة الصورية، فكل علم يعالج نوعا من الكيفيات التي تكون بمثابة صوره، ولكن صور هذه العلوم تكون مادة بالنسبة إلى المنطق، ومن ثم يجوز لنا أن نقرر " بأن المنطق أعلى العلوم صورية".
و ما نلاحظه على هذه المواقف المختلفة وإن كانت لا تختلف عن الموقف الأرسطي كما حددناه سابقا، فإنها تثير مشكلة هي المشكلة نفسها التي يطرحها الموقف الأرسطي. هل يمكن اعتبار المنطق ومناهج البحث شيئا واحدا؟ فإذا كان الموقف الأرسطي واضحا في التحليلات الأولى وهو أن المنطق علم صوري بحت، فإنه يعود في التحليلات الثانية إلى الواقع المادي لبرهنة تلك الصور. وهذا يجعلنا نفترض أنه كان يميز بين المنطق ومناهج البحث. فالصورية كانت بغية أرسطو وأن البرهان يأتي كمرحلة ثانية، وإن كان لا يصرح بذلك، نحن نستند في هذا الاستنتاج إلى طبيعة العلوم في تلك البيئة -و حتى في البيئة الإسلامية فيما بعد- لم يكن هناك انفصال بين العلوم والفلسفة. بل كانت الفلسفة تضم كل العلوم. لكن ما نلاحظه على هذه المواقف الحديثة- التي تعرف المنطق بأنه صوري ومادي معا- هي أنها لا تفصل بين المنطق ومناهج البحث وهذا على حد تعبير عبد الرحمن بدوي هو تقليد في كتب المنطق في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين كما تشهد على ذلك كتب: جون ستوارت مل نظام المنطق، سيغوارث المنطق، و.ف. برادلي المنطق، ج.ن. كينز دراسات وتدريب في المنطق الصوري. هـ .و.ب جوزيف مقدمة للمنطق. و.أ.س ستبينغ مقدمة حديثة للمنطق. وجونسون المنطق. وعشرات الكتب الأخرى، لكن لا يجد ما يمنع من اعتبار مناهج البحث في العلوم فرعا مستقلا عن المنطق رغم الصلة الوثيقة بينهما(91).
نخلص من خلال هذا التحليل الموجز إلى أن المنطق علم صوري، لأن طبيعة المنطق تقتضي بأنه لا يكون إلا صوريا. لكن ما هو مفهوم الصورية في المنطق؟ وهل الصورية تعني –كما هو شائع – الانفصال عن الواقع، وأن كون المنطق صوريا فهو عقيم؟
ثالثا: مفهوم الصورية في المنطق
يذهب موساوي إلى أن المنطق سواء في صورته القديمة أو في صورته المعاصرة لا يمكن أن يكون إلا صوريا بمعنى أنه يتعلق بصورة الفكر، أي بالطريقة التي نفكر بها دون أن ننظر إلى محتوى الموضوعات المعينة التي نفكر فيها(92).
ويذكر لوكاشيفيتش عبارتين يقول عن الأولى أنها مأخوذة من كتاب المنطق لكينز يقول فيها:" يقال عادة إن المنطق صوري، من حيث أنه لا يتعلق إلا بصورة الفكر، أي بالنحو الذي نفكر عليه دون نظر إلى الموضوعات المعينة التي نفكر فيها". والثانية يقول أنها مأخوذة من كتاب تاريخ الفلسفة للأب ويكلستون: "كثيرا ما يوصف المنطق الأرسطي بأنه منطق صوري. وهذا الوصف ينطبق على منطق أرسطو من حث هو تحليل لصورة الفكر". ثم يقول :" في هذين الاقتباسين عبارة لا أفهمها هي صورة الفكر"(93).
فينفي أن يكون المنطق علم قوانين الفكر كما يفهمه المتأثرون بالنزعة السيكولوجية. هذه النزعة التي تعد علامة على تدهور المنطق في الفلسفة الحديثة على حد تعبيره، وحسبه لا نجد لهذا المفهوم أثرا في كتاب (التحليلات الأولى). وهو الكتاب الذي عرض فيه أرسطو نظرية القياس. ويقرر كذلك أن المنطق لا يبحث في كيف يجب أن نفكر فهذه مهمة يختص بها فن يشبه فن تقوية الذاكرة. فعلاقة المنطق بالفكر لا تختلف عن علاقة الرياضيات به(94). ونفهم من هذا أن المنطق ليس علما معياريا.
فإذا كانت قواعد وقوانين المنطق تصاغ، عادة بصيغة الفعل "يجب"، فقد نفهم معان كثيرة من هذا الفعل:
معنى الإلزام: مثال يجب أن يحترم السائق إشارات المرور ومخالفتها تعرضه للعقوبة.
المعنى الشرطي: مثال: "يجب أن يكون الطالب مجتهدا إذا أراد النجاح". فالوجوب هنا مشروط بإرادة النجاح وليس أمرا مطلقا.
المعنى الصوري: مثال:"يجب أن يكون التالي صادقا في حالة صدق المقدم في علاقة اللزوم المادي" فالوجوب هنا يتعلق بصورة العلاقة لا بمضمونها لأنه يخص قاعدة اللزوم فقط.
إن هذا المعنى الأخير لفعل "يجب" هو المقصود في المنطق وكما هو واضح لا يفهم منه المعنى المعياري. كذلك المنطق لا يتناول الصدق من وجهة نظر مبحث القيم الذي يهتم بطبيعة القيم وأصلها وتطورها وعلاقاتها بالظروف الاجتماعية والتاريخية. فالمنطق يهتم بالصدق كقيمة بالمعنى الإخباري فقط؛ من حيث مطابقة الأقوال الخبرية (القضايا البسيطة) للوقائع التي تعبر عنها. أما بالنسبة للقضايا المركبة فصدقها صوري بحت يتحدد بدلالة القضايا البسيطة من خلال الرابط المنطقي الذي يربط بينها(95). إذن فصورة الفكر هي البحث عن العلاقات القائمة بين أجزاء الفكر بغض النظر عن محتوى الأجزاء.
تتكون صورة الشيء من العلاقات الكائنة بين أجزائه، بغض النظر عن مادة تلك الأجزاء، فنقول عن الشكل المعين إنه على صورة الهرم،إذا كانت العلاقات بين أجزائه مما يجعله على تلك الصورة الهرمية،مهما تكن مادته، إذ قد يصنع الهرم من حجر أو خشب أو ورق أو غير ذلك من المواد. ولو فككنا أجزاء الساعة وكوّمناها على المنضدة دون زيادة أو نقص، لما بقيت ساعة كما هي، لأنها فقدت صورتها حين تغيرت العلاقات التي كانت تربط بين أجزائها.
و المادة التي تعنينا في بحثنا هي الكلمات وما إليها من رموز، وهنا كذلك تكون صورة الكلام هي العلاقات الكائنة بين الأجزاء، بغض النظر عن تلك الأجزاء نفسها، ولذا فقد تكون الصورة واحدة في عبارتين مع اختلاف العبارتين في اللفظ والمعنى، مثال ذلك:
(مسألة صعبة) و(مدينة كبيرة).
فالعلاقات التي تربط جزئي كل من العبارتين، هي علاقة صفة بموصوف، ولو رمزنا في كلتا العبارتين بالرمز (س) للشيء الموصوف كائنا ما كان بالرمز (ص) للصفة كائنة ما كانت استطعنا أن نرمز لكل من العبارتين السابقتين بالصورة الرمزية ص (س) [ومعناها ص تصف س] ومن ثم يتبين كيف يتّحدان في الصورة رغم اختلافهما في اللفظ والمعنى. وبلغة المنطق هناك موضوع نحمل عليه محمولا معينا دون تحديد لمادة كل من هذا الموضوع والمحمول. فهناك صورة واحدة يمكن أن نسميها في هذه الحالات- مهما كان عددها ومهما كانت مادتها- (الصورة الحملية).
خذ مثالا آخر هاتين العبارتين:
1- الجزائر بين تونس والمغرب.
2- الكتاب بين الدواة والقلم.
فهما مختلفان في اللفظ والمعنى، ولكنهما متحدان في الصورة لاتحادهما في العلاقات الكائنة بين أجزائها، ولو استبدلنا بأسماء الأشياء رموزا في العبارة الأولى، مع احتفاظنا بالعلاقة، وجدنا الصورة متمثلة في الصورة الرمزية:(س بين ص وط) وهي صيغة رمزية تصلح صورة للعبارة الثانية كذلك(96).
وخذ مثالا ثالثا عبارتين أخريين مختلفتين مادة ومتحدتين في الصورة:
1- الحكم إما صادق أو كاذب.
2- الحكومة إما دستورية أو مستبدة.
3- فالصورة في كلتي العبارتين هي: (س إما ص أو ط).
ومن الملاحظ في هذه الأمثلة التي أسلفناها. أننا كلما أردنا استخراج الصورة من عبارة معينة،
استبعدنا ألفاظا واستبقينا أخرى، ومن هذه التي نستبقيها تتألّف الصورة، ففي عبارة (الجزائر بين تونس والمغرب)- مثلا – استبعدنا كلمات (الجزائر) و(تونس) و(المغرب) واستبقينا كلمتي (بين) و(و) فلما وضعنا رموزا بدل الكلمات المبعدة نتجت لنا الصورة الآتية:
(س) بين(ص) و(ط).
والفرق بين هذين النوعين من الألفاظ هو هذا: فأما الكلمات المستبعدة فأسماء لأشياء في عالم الواقع، ولذلك فهي تسمى بالكلمات الشيئية، وأما الكلمات الأخرى التي منها تتكون صورة العبارة فهي لا تسمى شيئا في عام الواقع، إذ ليس في عالم الأشياء شيء اسمه (و)؛ وإنما نضيف أمثال هذه الكلمات لنربط بها السماء الشيئية في بناء واحد، ولذلك جاز لنا أن نسميها بالكلمات البنائية، أو بالكلمات المنطقية، إذ على الرغم من أنها لا تدل على شيء في عالم الواقع، إلا أنه يستحيل علينا بناء فكرة بغيرها؛ ولئن كانت الألفاظ الشيئية من شأن العلوم الأخرى، فالكلمـات البنائية على وجه التحديد موضوع المنطق، فهو وحده الذي يحلل أمثال هذه الكلمات (إذا) و(إما... أو...) و(كل) و(بعض) و(ليس) ...إلخ. وهي كلها كلمات لا يمكن الاستغناء عنها في صياغـة كلامنـا –تكوين أفكارنا- مع أنها بذاتها لا تدل على مسميات بعينها في عالم الأشياء(97).
إن الصورة المنطقية تتعدد بتعدد الطرق التي ترتبط بها الألفاظ والجمل أو القضايا، وتكون دراسة المنطق منصبة على الشروط التي ترتبط بها هذه الصور دون المكونات الفعلية، ومن هنا جاء وصفه بالصورية(98).
يعـرض بلانشي بعض الأمثلة، يحاول أن يوضح من خلالها المقصود بصورة الفكر والصدق الصوري:
1- كل مثلث ذو ثلاثة أضلاع، إذن كل ذي ثلاثة أضلاع مثلث.
2- كل مثلث ذي أربعة أضلاع، إذن فبعض ذي أربعة أضلاع مثلث.
نلاحظ هنا أن الاستنباط الأول غير صحيح رغم صدق مقدمتيه، وأن الاستنباط الثاني صحيح رغم كذب مقدمتيه. إن هذا التمييز بين الاستنباطين ناتج عن مقابلتنا للصدق المادي بالصدق الصوري، فنقول عن استدلال صحيح إنه صادق بصورته، بصرف النظر عن صدق مادته، أي مضمونه(99). ويسمى المنطق صوريا لأنه لا يهتم إلا بهذه الصورة.
ويواصل بلانشي قائلا: ولننظر مرة أخرى في هذا القياس الذي ينسب لأرسطو، رغم أن هناك من يعتبره من وضع المشّائين.
كل إنسان فان
وسقراط إنسان
إذن فسقراط فان
إن صحة هذا الاستدلال ليست مرتبطة بالشخص الذي وقع عليه: فإذا صح هذا الاستدلال على سقراط فهو يصح على كل إنسان آخر في كل زمان وفي أي مكان، ومن هنا يمكننا أن نستبدل اسم سقراط بحرف (س) وهو متغير شخصي، يقوم بدور المتغير غير المعين ويمكن أن نضع مكانه أي إنسان أيا كان. ويمكننا أن نكتب الاستدلال مرة أخرى في هذه الصورة.
كل إنسـان فان
(س) إنســان
إذن (س) إنسان
ولنقم بخطو ثانية. لأن صحة الاستدلال لا تتوقف على التصورين الموجودين فيه: وهما إنسان وفان. فيمكن استبدالهما بالحرفين الرمزيين -دون أن يفقد الاستدلال شيئا من قوته- (هـ) و(و). ونكتب الاستدلال على هذا الشكل:
كل هـ - و
س – هـ
إذن س – و
وبهذا نكون قد استخلصنا الهيكل المنطقي للاستدلال وذلك بتعريته تدريجيا من محتواه الأول، ويبقى هذا الاستدلال صحيحا أيا كانت مادته، لأن صحته لا تتوقف إلا على صورة القالب الذي يظل ثابتا(100).
فإذا قلنا أن المنطق يبحث في صورة الفكر، نفهم من ذلك أنه يستخلص العلاقات التي تربط أجزاء الكلام، ثم يصنف تلك العلاقات ليميز بين المتشابه والمتباين، ومن ثم قيل عن المنطق أنه علم صوري، أي أنه يعنى بصورة الكلام دون مادته ومعناه(101).
والصورة لا تقتصر على المنطق وحده، وإنما تشمل كل العلوم، ولكن بدرجات؛ فكل قانون علمي هو تجريد لعلاقة لوحظت بين وقائع الطبيعة، بعد طرح الوقائع الجزئية ذاتها التي تمت ملاحظتها واستخلاص القانون منها، بواسطة الاستقراء والتعميم(102).
ووصف المنطق بالصورية يرجع إلى أنه لا يتعلق بمادة دون غيرها، بل شأنه دائما أن يضع المبادئ العامة للفكر أيا كان موضوعه، لهذا لابد للمنطق أن يكون عاما عمومية مطلقة، ولا يمكن الوصول على هذه الدرجة من التعميم بالاعتماد على مادة التفكير المحـــــــــددة.
فكلما ابتعد أي علم من العلوم عن المادة ازدادت درجة عموميته ولهذا استبعد المنطق كل اعتبار لمادة الفكر، فكانت مبادئه على قدر كبير من التعميم، وأصبح موقعه في أعلى سلم التعميم بين العلوم كلها، فهو علم صوري خالص(103).
خاتمة
المنطق الأرسطي رغم ما لحقه من تشويه لطبيعته من طرف الشراح والمتشيعين لهم من المدرسيين يبقى علما صوريا. فبالرغم من أن المنطق المعاصر هو أكثر صورية وتجريدا، فإن هذا ليس حجة على أنه يختلف عن المنطق الأرسطي. فالمنطق القديم أو المعاصر لا يمكن أن يكون إلا صوريا، بل كل العلوم تنطوي على جانب صوري، إلا أن هذه الصورية التي تكون مرادفة للتعميم أو التجريد، تكون نسبتها أعلى في المنطق، ثم تأتي الرياضيات بعد المنطق في درجة صوريتها أو عموميتها، ثم العلوم الطبيعية، ثم العلوم الإنسانية.
إن وصف المنطق كونه صوريا بالعقيم يلزم عنه وصف كل العلوم بالعقم، وهي نظرة لا يقبلها أي عقل سليم. فكون المنطق يتناول قضايا أكثر تعميما أو تجريدا، لا يعني أنه منفصل عن الواقع بقدر ما يعني أن درجة الصورية فيه أعلى من العلوم الأخرى.
إن الموضوعية في العلوم تقترن بدرجة التجريد أو الصورية. إن التجريد أصبح أمرا ضروريا في كل العلوم المعاصرة، فكلما أزداد العلم تعميما في قوانينه ازداد صورية، وكلما أزداد صورية أزداد موضوعية. وهو ما تثبته العلوم الفيزيائية من خلال النظريات الفيزيائية، فقد مرت النظرية العلمية بمراحل: نذكر منها مرحلة الارتباط بالحس والمعطيات الحسية، حيث كانت تكاد تخلو من اللمحات العقلية التفسيرية إلا في أضيق نطاق. وبالرغم من أن هذه المرحلة قد طالت لفترة بعيدة في حياة الإنسان، إلا أن الإنسان استطاع أن ينتقل إلى مرحلة ثانية، عندما أكتشف أن المعرفة الوصفية لا تكفي لفهم الطبيعة. أما في المرحلتين الثالثة والرابعة فقد خَفَتَ صوت المعرفة الوصفية وقل المضمون التجريبي، فاسحا المجال أمام اتساع أفق النظر العقلي، وبذلك صارت تفسيرات النظرية شديدة العمومية وأكثر دقة وقدرة على التنبؤ. ومن هذا تتضح لنا أهمية التجريد والتفكير الصوري في تطور العلوم ودقتها وهو ما يسعى إليه علم المنطق، باعتباره أعلى العلوم صورية.
مسعود بن سلمي
دراسات ما بعد التدرج سنة ثالثة دكتوراه جامعة الحاج لخضر. باتنة الجزائر.
........................
الهوامش
(74) علي عبد المعطي، السيد نفادي، أسس المنطق الرياضي، مرجع سابق، مقدمة.
(75) علي سامي النشار، المنطق الصوري(منذ أرسطو حتى عصورنا الحاضرة)، مرجع سابق، ص17-18.
(76) عصام زكريا جميل، المنطق والتفكير الناقد، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، ط1، 2012، ص28-29.
(77) علي عبد المعطي، السيد نفادي، أصول المنطق الرياضي، مرجع سابق، ص6-7.
(78) علي سامي النشار، المنطق الصوري(منذ أرسطو حتى عصورنا الحاضرة)، مرجع سابق، ص19.
(79) المرجع نفسه، والصفحة نفسها.
(80) أبو يعرب المرزوقي، إصلاح العقل في الفلسفة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1994، ص 144-145.
(81) علي سامي النشار، المنطق الصوري(منذ أرسطو حتى عصورنا الحاضرة)، مرجع سابق، ص19-20.
(82) ابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة، تح، عبد الله محمد الدرويش، مرجع سابق، ص264.
(83) علي سامي النشار، المنطق الصوري(منذ أرسطو حتى عصورنا الحاضرة)، مرجع سابق، ص21.
(84) جول تريكو، المنطق الصوري، مرجع سابق، ص42.
(85) علي سامي النشار، المنطق الصوري(منذ أرسطو حتى عصورنا الحاضرة)، مرجع سابق، ص22.
(86) جول تريكو، المنطق الصوري، مرجع سابق، ص44.
(87) علي عبد المعطي، السيد نفادي، أصول المنطق الرياضي، مرجع سابق، ص3.
(88) المرجع نفسه، ص4.
(89) المرجع نفسه، ص5.
(90) المرجع نفسه، ص5.
(91) عبد الرحمن بدوي، تدريس الفلسفة والبحث الفلسفي في الوطن العربي، مرجع سابق، ص54.
(92) أحمد موساوي، مدخل جديد إلى المنطق المعاصر، ج1، مرجع سابق، ص26.
(93) يان لوكاشيفيتش، نظرية القياس الأرسطية من وجهة نظر المنطق الصوري الحديث، تر، عبد الحميد صبره، دار المعرف الأسكندرية، مصر، 1961، ص25.
(94) المرجع نفسه، ص26.
(95) أحمد موساوي، مدخل جديد إلى المنطق المعاصر، ج1، مرجع سابق، ص27-28.
(96)عصام زكريا جميل، المنطق والتفكير الناقد، مرجع سابق، ص20-21.
(97) المرجع السابق، ص 22-23.
(98) محمد مهران، علم المنطق، مرجع سابق، ص26-27.
(99) روبير بلانشي، المدخل إلى المنطق المعاصر، تر، محمود اليعقوبي، ط2، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2009، ص14.
(100)روبير بلانشي، المدخل إلى المنطق المعاصر، مرجع سابق، ص16.
(101) عصام زكريا جميل، المنطق والتفكير الناقد، مرجع سابق، ص21-23.
(102) أحمد موساوي، مدخل جديد إلى المنطق المعاصر، ج1، مرجع سابق، ص32.
(103)محمد مهران، علم المنطق، مرجع سابق، ص25.
قائمة المصادر والمراجع
1- أميرة حلمي مطر، الفلسفة اليونانية (تاريخها ومشكلاتها)، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 1998.
2- أحمد الأهواني، أفلاطون، ط1، دار المعارف، القاهرة، مصر، 1965.
3- ابن سينا، منطق المشرقيين والقصيدة المزدوجة في المنطق، المكتبة السلفية الهاهرة، 1910.
4- ابن سينا، الشفاء،-قسم المنطق- مراجعة، إبراهيم مدكور، المطبعة الأميرية، القاهرة، 1952.
5- أحمد موساوي، مكانة المنطق في الفلسفة التحليلية المعاصرة، معهد المناهج، 2007.
6- أحمد موساوي، مدخل جديد إلى المنطق المعاصر، ج1، معهد المناهج، 2007.
7- ابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة، تح، عبد الله محمد الدرويش، ط1، دمشق، 2004.
8- أبو حامد الغزالي، مقاصد الفلاسفة، مطبعة السعادة محافظة مصر،ط1، 1512.
9- أبو يعرب المرزوقي، إصلاح العقل في الفلسفة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1994.
10- أندري لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، مج1، تعريب خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، ط2، بيروت، 2001.
11- إدموند هوسرل، مباحث منطقية، ج1، تر، موسى وهبه، المركز الثقافي العربي، بيروت، 2010.
12- الخوارزمي، مفاتيح العلوم، تح، إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط2، 1989.
13- بدوي عبد الفتاح محمد، فلسفة العلوم الطبيعية، دار المسيرة للنشر والتوزيع، ط1، عمان، 2011.
14- برتراند رسل، أصول الرياضيات، ترجمة محمد مرسي أحمد وأحمد فؤاد الأهواني، ج1، دار المعارف، القاهرة، 1962.
15- بيتر كونزمان، فرانز- بيتر بوركارد، فرانز فيدمان، أطلس الفلسفة تر، جورج كتورة، المكتبة الشرقية، ط2، بيروت، 2007.
16- بول موي، المنطق وفلسفة العلوم، تر، فؤاد زكريا، دار الوفاء، الإسكندرية، مصر،(ب ت).
17- جول تريكو، المنطق الصوري، تر، محمود يعقوبي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1992.
18- ويلارد كواين، بسيط المنطق الحديث، نقل أبو يعرب المرزوقي، دار الطليعة، ط1، بيروت، 1996.
19- روبير بلانشي، المنطق وتاريخه من أرسطو حتى راسل، تر، خليل أحمد خليل، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.
20- روبير بلانشي، المدخل إلى المنطق المعاصر، تر، محمود اليعقوبي، ط2، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2009.
21- محمود فهمي زيدان، المنطق الرمزي نشأته وتطوره دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، 1979.
22- محمد مهران، علم المنطق، دار المعارف القاهرة، 1978.
23- محمد ثابت الفندي، أصول المنطق الرياضي،دار النهضة العربية، ط1، بيروت،1972.
24- محمد عابد الجابري، مدخل إلى فلسفة العلوم- ج1- تطور الفكر الرياضي والعقلانية المعاصرة، دار الطليعة، بيروت، 1982.
25- ماهر عبد القادر محمد علي، التطور المعاصر لنظرية المنطق،دار النهضة العربية، بيروت، 1988.
26- محمد محمد قاسم، نظريات المنطق الرمزي، دار المعرفة الجامعية، مصر، 2002.
27- محمد عزيز نظمي، المنطق الصوري والرياضي، المكتب العربي الحديث، السكندرية، مصر، 2003.
28- نجيب حصادي، أسس المنطق الرمزي المعاصر، دار النهضة العربية، بيروت.
29- عبد الرحمن بدوي، ربيع الفكر اليوناني، وكالة المطبوعات الكويت، دار الفكر، بيروت، لبنان.
30- عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، ج2، سليمان زاده، ط2، 1429 هـ.
31- عبد الرحمن بدوي، تدريس الفلسفة والبحث الفلسفي في الوطن العربي، اجتماع الخبراء مراكش، المملكة المغربية، دار الغرب الإسلامي، ط1، 1990.
32- علي عبد المعطي محمد، والسيد نفادي، أسس المنطق الرياضي، دار المعرفة الجامعيةن الأسكندرية، القاهرة، 1988.
33- علي سامي النشار، المنطق الصوري(منذ أرسطو حتى عصورنا الحاضرة)، دار المعرفة الجامعية، 2000.
34- عصام زكريا جميل، المنطق والتفكير الناقد، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، ط1، 2012.
35- ياسين خليل، مقدمة في الفلسفة المعاصرة، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط2، عمان، 2012.
36- يان لوكاشيفيتش، نظرية القياس الأرسطية من وجهة نظر المنطق الصوري الحديث، تر، عبد الحميد صبره، دار المعرف الأسكندرية، مصر، 1961.
37- يوسف محمود، المنطق الصوري( التصورات والتصديقات)، ط1، دار الحكمة، الدوحة، 1994.
38- فؤاد كامل، جلال العشري، الموسوعة الفلسفية المختصرة، دار القلم، بيروت،لبنان، بدون تأريخ.