أقلام فكرية
مطارحات غرامشية (2): الدور العضوي للمثقف التقليدي
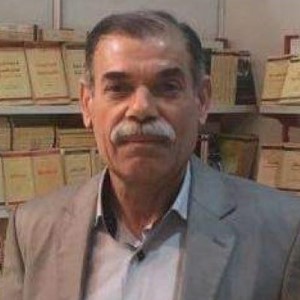
كنا قد تساءلنا في موضوعنا السابق ؛ إن كان بالإمكان حيازة المثقف (التقليدي) لدور المثقف (العضوي)، ومن ثم قدرته على انتزاع وظيفته والفوز بصفة (العضوية)، وها نحن نقدم – في هذا الموضوع - الإجابة التي نأمل أن تكون منطقية ومقنعة. والحال غالبا"ما حظي شخص المثقف (التقليدي) بالازدراء والاستخفاف من لدن الغالبية العظمى من الصحفيين والكتاب والباحثين المهتمين بالشؤون الفكرية والثقافية ؛ ليس من منطلق إدراكهم لطبيعة هذه الشخصية المركبة واستيعابهم لما تشتمل عليه من سمات وصفات، وإنما من باب ما تحمله صفة (التقليدية) الموشوم بها من إيحاءات مستكرهة وانطباعات مستهجنة، جرى استبطانها واجتيافها نتيجة الجاذبية القوية التي تتمتع بها خاصيتي (النمطية الذهنية) و(النسقية الثقافية).
ولهذا نلاحظ إن معظم أشكال (التبشيع) و(التشنيع) المساقة – حقا"أو باطلا"- ضد هذا النمط من الفاعلين الثقافيين، صادر من عناصر هي بالأساس مبتلاة – دون أن تعي ذلك - بالخصائص (التقليدية) و(النسقية) الموروثة، لا في وعيها الذاتي وتصوراتها الجمعية فحسب، وإنما في سلوكها اليومي وعلاقاتها المعاشة كذلك. ولذلك فهي حين تصدر أحكامها المتسرعة وتصوغ مقولاتها المبتسرة ضد ما تعتبره مخلفات ورواسب (تقليدية)، لا تنطلق مما يقع خلف المظاهر من علاقات وسيرورات وما تحت السطوح من ديناميات وصراعات، وإنما من منطلق مسبقات تصورية ومسلمات عرفية جرى حفظها في اللاوعي وأرشفتها في الذاكرة. ولهذا يكفي أن يوسم مثقفا"ما ب (التقليدية) حتى تتداعى الذهن جملة من الصفات السلبية والخصائص المنبوذة، التي من شأنها الحط من قيمته المعرفية والنيل من اعتباره الرمزي.
والآن، ما الذي يرشح المثقف (التقليدي) للقيام بدور المثقف (العضوي)، ويسمح له، من ثم، بممارسة وظيفته النوعية، وهو الذي يوصف بتقاطع مواقفه السياسية وقيمه الثقافية وتوجهاته الإيديولوجية، مع اتجاهات وسيرورات التطور التاريخي والحضاري للمجتمع ؟!. الحقيقة إن تفسير هذه الظاهرة يعتمد على رؤية إن المثقف (التقليدي)، هو - بالدرجة الأولى - كائن إنساني يعيش في كنف بيئة اجتماعية لها تاريخ وثقافة ودين وهوية ينفعل بها ويتفاعل معها، والتي غالبا"ما يكون إيقاع التغييرات في بناها والتحولات في أنساقها بطيئا"تحتاج معه إلى آماد زمنية متطاول، وهو الأمر الذي يجعل الجماعات المقصودة تبدي حرصا"أكبر إزاء مواريثها القديمة وممانعة أشدّ حيال ثقافاتها الأصولية. من هنا يبدو المثقف (التقليدي) يتمتع برصيد اجتماعي أغنى من نظيره (العضوي) لدى تلك الجماعات، كونه بمثابة الحارس المؤتمن على حماية تلك المواريث والثقافات من عوارض التغيير والتطوير. ولهذا فقد عبر بدقة المتخصص بحياة غرامشي وأعماله (جون كاميت) عن هذه الحالة قائلا"إن (المثقفون التقليديون، والذين لهم أهميتهم في المجتمع المدني، فيبدون أكثر ميلا"للتفاهم مع الجماهير وللحصول على الموافقة (العفوية) على النظام الاجتماعي).
ولعل حصول المثقف (التقليدي) على هذا الامتياز السوسيولوجي والتفوق الإيديولوجي، متأت من امتلاكه على أدوات (الهيمنة) السيكولوجية، فضلا"عن قدرته على ممارسة فرضها على تلك الجماعات التي تشاطره مواقفه وقناعاته بطريقة ناعمة. لذلك يستخلص (كاميت) حصيلة مهمة جدا"مفادها (إن حصول المثقف (التقليدي) على قبول دوره (العضوي) في المجتمع، طالما انه يحقق هدف (الهيمنة) على المكونات الاجتماعية، عبر أساليب القوة (الناعمة) بدلا"من أساليب القوة (الخشنة). لا بل انه وبحكم باعه الطويل في مجال الأساليب الناجعة لتحقيق (الهيمنة)، حينما كان في السابق يحتل ويمثل دور المثقف (العضوي) يمنحه الأفضلية، ليس فقط في مجال الاستحواذ على اهتمام الجماعات التي أشرنا إليها وينال رضاها فحسب، وإنما في مجال التأثير على نظيره المثقف (العضوي) عبر منافسته إياه في مضمار استمالة الفئات والشرائح المعدومة اقتصاديا"واجتماعيا"وثقافيا"صوب الآراء والأفكار التي يروجها ويدعو لها، فضلا"عن استدرار تعاطفها باتجاه القضايا والمسائل التي يتبناها ويدافع عنها، وبالتالي حيازة القدرة على التحكم بتصوراتها الإيديولوجية وتوجهاتها السياسية. ولهذا فقد لاحظ بحق بعض الباحثين إن (تأثير شريحة ثقافية ما على الشريحة العضوية السائدة ليس مباشرا"، ولكن قوة إيديولوجيتها وقدرتها على تنظيم البروليتاريا ذات نتائج حاسمة على حركة الأفكار العامة بما أن المثقفين السائدين لا يعودوا يحكمون بدون شريك منذ تلك اللحظة).
وعلى هذا الأساس يمكننا تفسير ظاهرة تفوق المثقفين (التقليديين) في المجتمعات المتخلفة على نظرائهم المثقفين (العضويين)، في مضمار تحقيق (الهيمنة) الإيديولوجية و(التحكم) السيكولوجي على شرائح واسعة من تلك المجتمعات، وبالتالي نجد صعوبة بالغة في انحسار دورهم الاجتماعي، وتلاشي تأثيرهم الإيديولوجي، وتقليص شأنهم السياسي.
***
ثامر عباس








