قضايا
ظاهرة العنف وأزمة الثقافات الفرعية
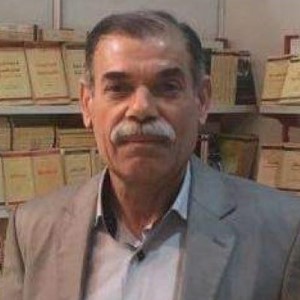
ليس غريبا "القول أن ظاهرة العدوان واستخدام العنف في المجتمعات البشرية قديمة قدم الإنسان ذاته؛ فهي لصيقة بطبيعة وجوده، وشاهد على اعتلال بيئته واختلال علاقاته، ودليلا"على قصور وعيه وانتكاس أعرافه، ومؤشرا"على تقهقر معاييره وانحراف قيمه. ولكنه، وبرغم ذلك ورغما"عنه، ما أن يدلف إلى حظيرة الاجتماع الإنساني ليلجم نوازعه وينظم علاقاته من جهة، ويضع أولى خطواته على سلّم الحضارة ويلج عوالمها المتنوعة ويستبطن فضائلها المتعددة من جهة أخرى، حتى يشرع بتشذيب أنماط سلوكه، وتقويم معايير أخلاقه، ويهتم بتلطيف حدة طباعه، ويميل، من ثم، إلى الكفّ عن التطرف في ضروب الفكر والامتناع عن العنف في ميادين الواقع. بيد أن الغريب في هذه المسألة حقا"، هو أن يتحول العنف إلى واقعة مستديمة تتحكم بآفاق مصيره وتقرر مآل خياراته، الأمر الذي يتطلب البحث عن جذور تلك الظاهرة، ويستقصي عوامل تكوينها في المجتمعات المأزومة سياسيا"والمخترقة حضاريا"؛ لا في إطار الأوضاع القائمة والظروف الراهنة فحسب، التي قد توحي بأنها المسؤولة عن اندلاع تلك النزعات وانفلات زمامها وتفاقم ميولها، وإنما بالتنقيب عن بواعثها الاجتماعية المضمرة، والحفر في طبقاتها النفسية المخفية، والكشف عن ملابساتها السياسية المتقادمة. ذلك لأن (العنف – كما يؤكد أحد علماء الاجتماع الغربيين- يقوم حيثما تخضع القيم والأهداف التي تخص فردا"أو جماعة، والتي تنطوي على معنى عام كلي، لقمع يمارسه حيالها فردا"آخر أو جماعة أخرى. وفي حال حدوث عنف ظاهر، واضطرابات اجتماعية أو ثورة، يجدر بنا أن نتساءل ما هي مجموعة القيم، وما هو النظام الثقافي الذي عانى من القمع طوال هذه المدة، حتى لم يعد يجد من سبيل للتعبير عن ذاته إلاّ الثورة)(1).
ولا ريب فقد اجتهدت العديد من النظريات النفسية والفلسفات الاجتماعية، في تفسير هذه الظاهرة لجهة حصر أسبابها وتقنين منطلقاتها، بحيث ذهب البعض منها إلى الزعم بان ارتباط العنف بالإنسان هو من باب ارتباط العلة بالمعلول،على اعتبار إن السلوك العدواني هو منزع بيولوجي مقرر في طبيعة الكائن الاجتماعي. هذا ما تؤكده، على سبيل المثال لا الحصر، نظرية (التحليل النفسي) بصيغتها الفرويدية من خلال تمسكها بالأطروحة القائلة : إن العدوانية ليست أمرا"عارضا" أو طارئا"ينتاب المرء ضمن مرحلة من مراحل سيرورته الاجتماعية، لا يلبث أن يتخطاه ويتجاوز آثاره فيما هو يدلف حقبة أطواره الحضارية، إنما هي ركن أساسي ومقوم بنيوي من مقومات كينونته الانطولوجية. هذا في حين تعتقد بعض النظريات الأخرى؛ إن ظاهرة العنف المصاحبة للإنسان والممسكة بتلابيبه، تشكل قرينة رمزية لا يصعب إدراكها على تفاقم أزماته الحضارية، مثلما يمكن اعتبارها أحد أوجه محاولاته للتغلب على معاناة استلابه القيمي، والإفلات من دوامات اغترابه الاجتماعي. وقد عبر عن هذا التوجه أحد أشياع النظرية السوسيولوجية (تونيز) حين كتب يقول (طالما إن كل شخص يبحث في المجتمع عن فائدته، ويجاري الآخرين إلى المدى والوقت الذي يبحثون فيه مثله عن نفس الفوائد، فان علاقة الكل بالكل، فوق ووراء الاتفاق يمكن اعتبارها عداوة مقنعة أو حرب مستترة)(2).
وبصر النظر عن القيمة العلمية لتلك الطروحات ومتانة الأسس المنهجية التي تقوم عليها وتنطلق منها، في رصد مقومات ظاهرة العنف وتحليل أنماطها، فإنها ستجانب الصواب وتنأى عن السداد إن هي أهدرت حقيقة الاختلاف النوعي بين المجتمعات، وتجاهلت واقعة التفاوت الحضاري بين الأمم. الشيء الذي يستلزم التروي في صياغة الأحكام الجازمة، والحذر من إطلاق التعميمات القطعية، حيال البحث عن بداهات نشوء تلك الظاهرة وتعيين منطلقات تكوينها، فضلا"عن استخلاص الكيفيات المسؤولة عن تبلور عناصرها وانبعاث ملامحها،عبر تشققات كيان المجتمع المعني وتمزقات وحدة نسيجه. صحيح أنها (= ظاهرة العنف) من حيث المبدأ أضحت تشكل القاسم المشترك لمعظم شعوب العالم، بمختلف أصولها وتباين أعراقها وتنوع ثقافاتها وتعدد أديانها، إلاّ إن مغزى دوافعها وزخم انفلاتها وشدة وطأتها، تتفاوت من بلد لآخر ومن مجتمع لآخر، لا بل إن شدة إيقاعها لا تلبث أن تتغير من فترة لأخرى ضمن البلد الواحد وفي المجتمع نفسه.
فتعاطي الإنسان الغربي،على سبيل المثال لا الحصر، مع ظاهرة العنف إبان فترة وقوعه تحت طائلة المنافسات الاقتصادية الضارية، وانخراطه في أتون الصراعات السياسية الشرسة، وانهماكه في دوامة الحروب الدينية القاسية، لا تشبه في شيء إجراءات تعاطيه لذات الظاهرة في مراحل لاحقة، لاسيما بعدما بلغ مستوى الإشباع المادي لحاجاته، وتخطى عتبة النضوج الفكري لطموحاته. وحقق، بالإضافة لذلك، حالة من التوازن السياسي والاستقرار الأمني والتعايش الاجتماعي، بفعل جملة من الشروط الذاتية والتوافقات الموضوعية – ليست هذه الدراسة محل تناولها - بحيث إن بوصلة اهتماماته تحولت صوب البحث عن السبل القمينة بالإبقاء على مستوى رخائه الاقتصادي، والمحافظة على وتيرة تطوره الاجتماعي، والثبات على سياق رقيه الحضاري.
ولهذا فان أي تغيير يطرأ على تلك الأوضاع ويطال تلك المستويات، سرعان ما يعتبر بمثابة الصاعق الذي لا يلبث أن يفجر بواعث قلقه ويضاعف وساوس مخاوفه، ويصعّد بالتالي محفزات تعاطيه للعنف ويسوغ مبررات انخراطه في العدوان. هذا في حين نجد، بالمقابل، إن مظاهر التعصب القومي والتطرف الديني، التي تجتاح وجود الإنسان في المجتمعات الموصوفة بالتخلف الاجتماعي والممهورة بالطغيان السياسي، ناهيك عما يتمخض عنها ويترتب عليها من استشراء نوازع العنف ودوافع العدوان، تتغذى من مصادر أخرى وتمتح من أصول مغايرة، لا تمت بصلة لتلك التي ألفيناها تحرك كوامن الظاهرة وتدير دفة اتجاهاتها في المجتمعات الغربية المتقدمة. إذ إن طبيعة النظم السياسية الحاكمة، ونمط العلاقات الاجتماعية القائمة، وشكل البنى الحضارية السائدة، ومحتوى القواعد الأخلاقية الفاعلة، وقيمة الرموز العرفية المهيمنة، لا تفترض فقط حصول الاختلاف في نوع المدخلات القيمية المسؤولة عن ضبط العلاقة بين التوافق النفسي والتكامل الاجتماعي، على صعيد (الذات – الأنا) لكل منهما فحسب، وإنما تستوجب وقوع التعارض في نمط المخرجات السلوكية الموكول إليها تحقيق التوازن وبلوغ التكافؤ على مستوى الندية مع (الآخر – الأنت) كذلك.
وعلى هذا الأساس، وبقدر ما يكون للعنف من أسباب ظاهرة مختلفة ودوافع خفية متباينة، بقدر ما تكون الأوجه التي يتمظهر بها متنوعة، والمسالك التي يتسرب منها متعددة. وإذا كان الإنسان في المجتمعات المتقدمة، يمتلك آليات سياسية مشروعة، ويمارس فعاليات اجتماعية متحضرة، يستطيع من خلالها التعبير عما يشعر به من هموم ويطرح ما يعانيه من مشاكل، الأمر الذي تتيح له (= الآليات والفعاليات) فرصة المشاركة في استخلاص أشكال خياراته، واستنباط أنواع تطلعاته، ورسم معالم مستقبله، ضمن أطار دولة يحكمها القانون وتؤطرها المؤسسات، قادرة على استيعاب إرهاصات الثقافات الفرعية، واستدماج خصائصها في بوتقة الثقافة الوطنية الشاملة والموحدة، حيث تنتفي الحساسيات العرقية وتختفي الصراعات الطائفية. نعم قد تندلع هنا أو هناك بعض مظاهر العنف على خلفية الأحقاد الاثنية أو الضغائن الدينية، بيد أن ذلك يحصل من باب الاستثناء وليس القاعدة، كما هو الشأن في المجتمعات المتخلفة، التي أمسى تعاطي القوة في أوساطها ليس شائعا"فقط بل ومسوّغ أيضا"، حيث لغة العنف هي المفضلة وعرف العدوان هو السائد.
ففي هذا الشطر من المجتمعات القابعة خلف التاريخ والزاهدة بمعطيات الحضارة، تنقلب معالم الصور وتختلف معايير التصور؛ حيث مضاعفات الطغيان السياسي دائمة، ومخلفات الحرمان الاقتصادي مزمنة، وتداعيات القهر الاجتماعي متواصلة، وترسبات الكبت النفسي مستمرة، وتركات الجدب الثقافي متطاولة. كل هذه المساوئ وغيرها الكثير تركت بصماتها وحفرت آثارها في بنى هذه المجتمعات، بحيث نخرت أسسها المادية وقوضت دعائمها المعنوية، الشيء الذي أفضى – دائما"وفي مطلق الأحوال – إلى استدراج دوافع العنف واستدعاء مبررات العدوان. ذلك لأن الظروف في مثل هذه الأجواء الملبدة والأوضاع المكفهرة، تغدو مؤاتية لكي تعم الفوضى ويستشري الفساد في جميع مفاصل الدولة ومجمل قطاعات المجتمع، بعدما يتم تغييب القانون الوضعي وتعليق الشرعية الدستورية من جهة، وتخصيب نوازع الشخصنة للثوابت الوطنية، وازدراء القيم الاجتماعية ونبذ المعايير الأخلاقية من جهة أخرى. كل ذلك على خلفية جملة من الأساليب والممارسات التي من أبرزها؛ إن وسائل الإعلام الرسمية ومؤسسات الرأي العام تتحول من أداة لتنوير الوعي وتثوير الواقع، فضلا"عن إشاعة الروح المواطنة وتربية حسّ المسؤولية الوطنية، إلى مجرد مواخير تعمية وإفساد تمارس من خلالها عمليات غسل أدمغة المواطنين بالترهات، وتسطيح وعيهم بالخرافات، وشلّ إرادتهم بالممنوعات، واخصاء شخصيتهم بالمحرمات.
وحيث لا عاصم من بطش السلطة المستبدة وطغيانها الأمني، ولا رادع لإرهاب الدولة الشمولية وجبروتها البوليسي، ناهيك عن شباك ومصائد علاقات الاستزلام والاستتباع، التي تحاصر الفرد وتضيّق الخناق عليه في كل مفردة من مفردات حياته الخاصة والعامة. فانه لا حيلة له ولا خيار أمامه إزاء مجابهة فلتان مقومات الحاضر ومجهولية مكونات المستقبل، بعد أن فقد غطاء القانون وجرّد من حماية الدولة وأقصي عن ولاء الوطن، سوى اللجوء إلى سواتر ثقافاته الفرعية (العنصرية والطائفية)، والانكفاء إلى قواعد علاقاته الأولية (الأسرية والقبلية)، يطلب منها الحماية وينشد فيها الأمان ويجد لديها الكرامة، وهنا إذاك تكمن المفارقة والمأساة معا". ولما كان المجتمع المتخلف – في الغالب – متأزم سياسيا"ومتصدع اجتماعيا"ومعبأ إيديولوجيا"ومحتقن نفسيا"، فان ذلك يجعله عرضة مستمرة لانهيار أمنه الشخصي وتداعي استقراره العائلي، ويصبح، تبعا"لذلك، بمثابة حقل خصب لتفريخ الفتن بين (الملل والنحل) ومضمار واسع لتصفية الحسابات بين (الجماعات والكتل). وهذا ما لاحظه أستاذ علم النفس (مصطفى حجازي) حينما وصف ذلك بالقول (يبقى المجتمع المتخلف يضجّ بالعنف، يمارس على إنسانه ويصدر عنه في آن معا"، حتى في أكثر المظاهر سكونا"ودعة واستسلاما")(3).
وفي ظل غياب الثقافة الوطنية الشاملة، وانعدام الثوابت الرمزية الموحدة، وخشية الاضطهاد السياسي والتهميش الاجتماعي والإقصاء العرقي والاستبعاد الطائفي، يعمد كل فريق سياسي أو طرف جماعي إلى استنفار مخزون ثقافاته الفرعية، واستحضار رصيد مواريثه القبلية، واستصراخ حميات ولاءاته الجهوية، بغية الانكفاء إليها الاحتماء فيها والاتكاء عليها، ساعيا"من وراء ذلك إلى تغليب مصالحه الآنية وفرض وجهة نظره الجزئية وترويج قيمه التحتية، والمواظبة، من ثم، على توسيع دائرة نفوذه ونشر مضمون أفكاره وترسيخ سلطان معتقداته. نقول انه في مثل هذه المعطيات والتداعيات فان ديناميات اشتغال الثقافات الفرعية (العنصرية والطائفية والعشائرية)، تتحول من وظيفة شدّ لحمة المجتمع ولملمت شعثه ورأب صدوعه وترميم تشققاته، إلى عوامل أساسية في تعميق الخلافات بين مكوناته، وتأكيد التمايزات بين عناصره، وتأجيج الصراعات بين جماعات، وترسيخ الانقسام بين ذاكراته، وتعميم العدوات بين هوياته. وفي سياق الولاء القائم على العجز والخضوع – كما يستنتج الباحث (هشام شرابي) – (يبدو جليا"أنه لا يمكن تصور فكرة العقد الاجتماعي.. ولأن المعارضة الشرعية غير ممكنة، فان التآمر والتمرد يصبحان البديلين الوحيدين. وعلى نحو مماثل فحين يحضر النقاش العلني، فان التآمر والعنف هما الشكل الباقي للإقناع)(4).
وهكذا فان أزمة المجتمع المتخلف، لا تخرج عن كونها انعكاسا"لأزمة ثقافاته الفرعية، وقصور ولاءاته الأولية، وانتكاس انتماءاته الهامشية، والتي لا تشرأب رموزها وتتوثب أعرافها وتنثال قيمها وتسلل عاداتها، إلاّ على أشلاء الثوابت الوطنية للدولة، ونفي الخصائص المعيارية للمجتمع. ولكي تتجاوز الأولى عوامل ضعفها ومحنة تفككها، ويتخطى الثاني عواقب أزمته وينهض من حطام كبوته ويستأنف خطى مسيرته، لابد أن تستعيد الثقافة الوطنية الموحدة عافيتها وتتمكن من بسط سلطانها، ليس فقط على المستوى المادي المتمثل بالإطار الجغرافي / السيادي فحسب، وإنما – وهو الأهم في اعتقادنا المتواضع – على المستوى الاعتباري / الرمزي، لكي تترسب بين تضاعيف الوعي الفردي، وتترسخ داخل أروقة المخيال الجمعي على حدّ سواء.
***
ثامر عباس
.........................
الهوامش
1. قيليب برونو؛ العنف وعلم الاجتماع، ضمن المؤلف الجماعي؛ المجتمع والعنف، ترجمة الأب الياس زحلاوي والأستاذ أنطوان مقدسي، (بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات / مجد، 1985)، ص86.
2. المصدر ذاته؛
3. الدكتور مصطفى حجازي؛ التخلف الاجتماعي : سيكولوجية الإنسان المقهور، (بيروت، معهد الإنماء العربي، 1976)، ص255.
4. الدكتور هشام شرابي؛ النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي، (بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1993)، ط2، ص65.








