قضايا
العقد الاجتماعي بين إهمال الدولة وتجاهل المجتمع
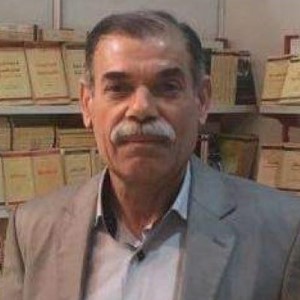
لعل القارئ المتابع يعلم علم اليقين، كما بات لا يخفى على أحد من العراقيين، إن تجّار الحروب الأهلية وسماسرة الفتن الطائفية ودهاقنة الكراهيات العنصرية، ليسوا فقط غير جديرين بتحمل المسؤولية الوطنية، والاهتمام بالمصائر الاجتماعية، والانهمام بالمصالح الاقتصادية، والاضطلاع بالمهام التاريخية، والاعتبار بالاصول الحضارية فحسب، إنما كونهم لا يصلحون بتاتا"لأن يكونوا نماذج سياسية يقتدى بمواقفهم، كما لا أمل مطلقا"في أن يستحيلوا إلى أمثلة أخلاقية يحتذى بمناقبياتهم. إلا أن ذلك لا يمثل – في إطار هذا الموضوع – سوى الوجه المنظور والمكشوف لجسامة الفجيعة المحيقة ؛ لا بالواقع العراقي الحالي كمجتمع موحد وثقافة مشتركة وهوية جامعة وذاكرة راسخة فحسب، بل وكذلك بمصيره المستقبلي كتاريخ متواصل وجغرافيا ثابتة ووطن قار وكيان متجذر.
فمنذ أن أسقطت دعائم النظام السابق وتهاوت قلاع سلطته وتناثرت أشلاء هيبته، لم يترك المعنيون بشؤون الدراما العراقية ركنا"من أركان النظام السياسي القائم حاليا"، دون التعرض لسياساته بالنقد ولإجراءاته بالإدانة، كما لم يهملوا زاوية من زوايا السلطة الحالية، دون التنديد بانحراف مؤسساتها والتشهير بمفاسد رموزها. لا من باب أنها فشلت فشلا"ذريعا"بتجاوز ما كانت تزعم أنها تركات النظام الدكتاتوري البائد ومخلفات السلطة التوتاليتارية المقبورة، مثلما أخفقت إخفاقا"ذريعا"بتحقيق ما توهمت أنها جاءت بصدد؛ إنهاء التجاوزات السياسية، وتعويض الحرمانات الاقتصادية، وإشباع الاحتياجات الاجتماعية،وتوفير الأجواء الديمقراطية. إنما من منطلق كونها ضاعفت من أشكال ذلك الاستبداد، وعمقت من ضروب تلك المساوئ.
والواقع إن كل الذي تعرضت له الحكومة الحالية من وابل النعوت السلبية والأوصاف المستهجنة – التي بالتأكيد تستحقها وتليق بها – لا يوازي ما اقترفته بحق هذا البلد من آثام وقبائح، كما لا يرقى إلى مستوى ما اجترجته ضد هذا الشعب من كوارث متلاحقة ومصائب متتالية. بيد أن تناول مسألة ما من منظور ذاتي /معياري شيء، والتعامل مع ذات المسألة من منظور موضوعي / إجرائي شيء آخر تماما". بمعنى إن الادراكات الشخصية والتصورات الذاتية، لا ينبغي لها أن تكون معيارا"يركن لحياديته عند تقييم وتقويم القضايا المتعلقة بآليات سلطة الدولة وخيارات سياسة الحكومة وتطلعات حراك المجتمع، ما لم تطرح على بساط البحث وتوضع تحت مشارط التحليل، جميع أطراف القضية المعنية وكافة عناصر المشكلة المقصودة. بحيث تأني الاستنتاجات وتتمخض التوقعات أقرب إلى الواقع الملموس منها إلى الهلوسة، وأدنى إلى الحقيقة المعاشة منها إلى السفسطة.
ومن هذا المنطلق فانه قلما أشار أحد من أولئك الكتاب والباحثين لدور الطرف الآخر (الشعب، الجمهور، المواطنين) من العقد الاجتماعي، حيال تحمل قسطه – وهو وافر وأساسي كما نعلم – من المسؤولية الوطنية، فضلا"عن التقيد بالتزاماته الأخلاقية وتنفيذ واجباته الاجتماعية، بعد أن ذاق وبال أمره وتجرع مرارة تصرفاته. صحيح إن روابط الثقة المفترضة بين الدولة والمجتمع مقطوعة، وان أواصر الصلة المتخيلة بين الحكومة والمواطنين منعدمة، على خلفية غياب شروط الشرعية وفقدان المشروعية بين أطراف ذلك العقد. وهو الأمر الذي يفسر لنا سرّ إمعان الإنسان العراقي في إهمال وتجاهل كل ما له صلة بسلطات الدولة في الحالة الأولى، كما ويكشف عن خلفيات إسرافه في تخريب ونهب كل ما له علاقة بممتلكات الحكومة في الحالة الثانية. إلاّ إن نداء الواجب وسياق الضرورة يحتمان علينا ألاّ ننسى – ونحن في إطار توجيه اللوم إلى الدولة الحالية وكيل الاتهام إلى الحكومة القائمة، على خلفية استشراء مظاهر العجز المؤسسي وتفشي ظواهر الفوضى المعيارية – إن ينال المواطن قسطه من الإدانة القاسية ويحظى بحصته من الاتهام الجارح. ليس فقط لأنه شحيح الإحساس بالمسؤولية الوطنية، وقليل التعاون مع السلطات الحكومية، وضعيف الإدراك لواجباته الاجتماعية فحسب، وإنما لكونه – فضلا"عن ذلك – لم يتردد بإطلاق العنان لعبث غرائزه البدائية، ولم يحجم عن تسعير نزعاته التدميرية، ولم يسعى لكبح طيش نزواته الانتقامية.
ذلك لأن جوهر مفهوم العقد الاجتماعي لا ينطوي على معنى الإذعان لرغبات النظام السياسي – بصرف النظر عن طبيعته – وهذا ما دعا (روسو) إلى القول (إن الشعب الذي يعد بالطاعة والخضوع يفقد صفته كشعب)، أو التماهي مع توجهات الدولة – بصرف النظر عن ماهيتها – بقدر ما يتضمن مغزى الالتزام بمتطلبات الشأن العام وتواضعات المصلحة المشتركة. ناهيك بالطبع عن الذود عن حقوق الإنسان – بصرف النظر عن أصوله وخلفياته – والدفاع عن الحريات العامة – بصرف النظر عن طبيعتها ومضمونها -. ولأن التذرع بتقصير الحكومة حيال تأمين الاحتياجات وتحسين الخدمات وتوفير الضمانات – وهو واقع لا يمكن إنكاره – لا يمنح المواطنين المحرومين من تلك المطالب المشروعة، الحق في التجاوز على الممتلكات العامة أو يبيح لهم سرقة المال العام، تعبيرا"عن السخط والاحتجاج الذي يضمرونه حيالها. كما إن التعكز بحجة تنصل الدولة عن مسؤوليتها في الحفاظ على أمن المجتمع وضمان استقراره، فضلا"عن طمأنة حقوقه واحترام كرامته، لا يعطي الأفراد والجماعات المسلوبة حقوقهم والمنتهكة كرامتهم،غطاء الشرعية لإضعاف هيبتها السيادية والتطاول على رموزها الجمعية،استجابة لمشاعر الرفض والممانعة التي يكنونها ضدها.
ولذلك فان محاولات تجسير الفجوة المتوطنة بين الدولة والمجتمع، وردم الهوة المزمنة بين الحكومة والمواطنين سوف تبوء بالفشل، طالما تجري على أساس الوعظ الأخلاقي المقرون بالطوباويات، أو تتم بالعزف على أوتار الأصالة التاريخية المشفوعة بالأسطوريات – كما يجهد بعض الكتاب دون جدوى للأسف – إذ إن توجّه كهذا قمين بتكريس عوامل التصدع في الذهنيات بدلا"من تماسكها، والتقطّع في السيرورات بدلا"من تواصلها، ومن ثم تحفيز الانتماءات الهامشية خلافا"لوحدة المجتمع، وتنشيط الولاءات التحتية خلافا"لسلطة الدولة، وتفعيل الحميات التعصبية خلافا"لشرعية الحكومة.
وفي ضوء ما تقدم فان وسائل الإعلام بكل أصنافها وعناوينها، باتت مطالبة اليوم قبل أي وقت مضى، بإطلاق حملات توعية وطنية / سياسية واسعة ومكثفة، لا تستهدف رموز الدولة التي شلت قدراتها المحصصات الداخلية وعطلت إرادتها الأجندات الخارجية. كما لا تضع في اعتبارها رموز الحكومة التي استهلكتها الصراعات الطائفية واستنزفتها الاستقطابات الجهوية، بقدر ما تركز وابل (قصفها) على عقول المواطنين الذين اختلطت في تصوراتهم المعايير، وتداخلت في إدراكاتهم الأبعاد، وتلابست في أذهانهم العلاقات. بحيث يكون بمقدورهم التمييز بين الأولويات والتفريق بين الخيارات، التي من شأنها أن تتيح لهم استدخال الوقائع واستبطان الحقائق التي مؤداها ؛ إن تحطيم آلة الدولة في مصنع، أو سرقة أداة من ورشة، أو تزوير وثيقة في مؤسسة، أو الغش في امتحان مدرسي، أو التجاوز على شبكات الماء والكهرباء، أو حتى رمي الأنقاض والنفايات في غير الأماكن المخصصة لها، سوف لن يضعف جبروت الدولة بقدر ما يجعلها أكثر تغولا"بزعم تميكن السلطة، ولن يقلل من تعسف الحكومة بقدر ما يجعلها أكثر توحشا"بحجة فرض النظام، وبالتالي فان الضرر سيقع أولا"وأخيرا"على المجتمع الذي لم يحسن الحفاظ على عقده الاجتماعي، وان المعاناة ستطال دائما"وأبدا"المواطن الذي لم يشأ القيام بمسؤوليته الوطنية، كما يفترض به أن يفعل !.
***
ثامر عباس








