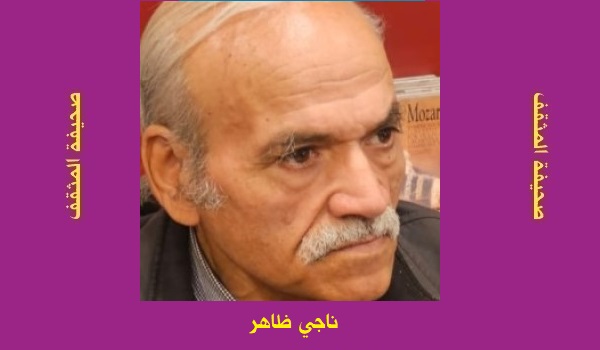حوارات عامة
جمال الهنداوي يحاور الروائي المغترب د. قصي الشيخ عسكر

* ولدتم في البصرة وعشتم مراحل عديدة بين العراق وسورية والدنمارك وبريطانيا كيف أثّرت هذه الرحلة الطويلة على تكوينكم الأدبي والإنساني.
- أضيف إلى ما ذكرتم المغرب وليبيا حيث كنت أدرّس في الثانويّة هناك. سنتين بقيت في شمال المغرب. وأكثر من ستة أشهر في ليبيا حيث درّست أيضا في مدرسة ثانوية. العيش يختلف في المغرب وسوريا ولبنان عن العيش في أوروبا. والسبب هو علمك أنّك لن تستقرّ في هذه الدول، مستقبلك ضائع.. حالما ينتهي عقد عملك لا تدري ماذا تفعل. من الناحية النّفسية تشعر أنك تضيع.. مستقبل مبهم، مع معاناتك اليومية تعيش التناقض: جمال المغرب، الناس الطيبون، التسامح، الحبّ للآخر، احتضان الغريب، في الوقت نفسه تعيش حالات قاسية: ترى شابّا يجلس على الرصيف ينتظرك أن تنتهي من طعامك في المطعم، وحالما تنهض من على المائدة يدخل ليحمل بقايا الطعام ويلتهمه. السرقات، الحشيش، قضايا تعيشها كل يوم، لكنك تشعر بالأمان كون الناس مسالمين، في ليبيا تعيش حالة أخرى، مثلما تخرج من مكان بارد لتدخل غرفة فيها درجة الحرارة أكثر من خمسين، الناس اختلفوا عن طيبة المغرب، في ليبيا مظاهر عسكرية في كل مكان، المجتمع نفسه ينظر إلى الغرباء نظرة احتقار.. التعالي، الجيوب مليئة بالنقود لكنْ هناك روح عدائيّة للآخر لا مثيل لها، العيش في المغرب وليبيا، منحني دافعا لأن أكتب فيما بعد رواية (الرباط) طُبعت ونشرت في سورية، وهناك رواية تخص ليبيا، وقصة طويلة لم تنشرا بعد.
أمّا العيش في سوريا فقد اختلف كثيرا. المجتمع السوري قريب من المجتمع العراقي. كنت أحمل معي من العراق ثلاث روايات هي الروايات الواقعية التي كتبتها في العراق وحملت مخطوطاتها معي عندما سافرت ولم أرجع، وفي دمشق ولبنان بدأت التأليف في المرحلة الجديدة، معنى ذلك التأسيس لمرحلة فنيّة جديدة، فقد كان الكبار الذين سبقونا مثل محفوظ وغيره يكتبون على وفق نمط واحد، نمط اتباعي واقعي بحت بتقنية عالية وهي الصفة التي امتاز بها محفوظ غير أننا نحن الجيل الجديد أردنا أن نقدِّم تيارا مميّزا في الرواية . عن نفسي بدأت بتجربة الرواية القصيرة طبعت رواية (سيرة رجل في التحولات الأولى) و(شئ ما في المستنقع) وهي عن رجل يعثر على جثة مبعثرة فيجمعها ليجد أنها جثته هو، بعد معاناة من الرقيب طبعت الرواية، وهناك الرواية الساخرة (للحمار ذيل واحد لاذيلان)التي أنتقد فيها الحروب.. لقد كان وجودي في سوريا حافزا لتقديم أعمال جديدة وتيار جديد هو تقنية الرواية القصيرة الجديدة، التردد على لبنان أفادني في التقاط بعض الحالات، فكتبت القصة الطويلة (كان الهدوء يأتي متأخرا) التي حوّلّتْها بعض فصائل المعارضة العراقية من الأدباء والفنانين في رفحاء إلى تمثيلية وقدمتها في إذاعة المعارضة، ونشرتها فيما بعد مجلة الاغتراب الأدبي التي كانت تصدر من لندن وكانت هناك تجربتي في القصة القصيرة إذ نشرتُ قصصي في مجلة العربيالكويتيّة الشَّهيرة، إحدى القصص قُدِّمَتْ على شكل تمثيليّة تحاور حولها المستمعون في بثّ مباشر من قبل إذاعة دمشق.
لا أقول إن التغيير شمل في تلك الفترة الرواية فقط.. بل كانت هناك محاولات في الشّعر للإفلات من قبضة السيّاب والرواد فجاءت وأول مابدأ التغيير -قبل قصيدة النثر- في محاولات بعض شعراء التفعلية الذين خرجوا عن نظامها الذي وضعه السيّاب ونازك في نهاية السطر فقد اختلف عدد التفعيلات في كلّ سطر مع بقاء نهاية الأسطر موحّدة التفعيلات. أول خرود كان في اختلاف نهاية الأسطر الأمر الذي أزعج نازك الملائكة وذكرته في كتابها قضايا الشّعر المعاصر، وحذّرنا منه أساتذتنا في جامعة البصرة حيث سمّاه أستاذنا د زاهد العزي، فوضى نهاية الأسطر، وقد سمّاه بعض الأكاديميين فوضى الأسطر، وكانت هناك أيضا تجارب أدونيس التي يزجّ بها في كلمات نثرية خلال قصائده، أو يضع هوامش توضيحيّة لبعض القصائد ثمّ جاءت بعد هذه الفوضى قصيدة النثر التي نُسبت زورا إلى شعراء الثمانينيّات وهي في الأساس نشأت على يدي حسين مردان ومحمّد الماغوط.
* درستم الأدب العربي في البصرة ودمشق، ثم أكملتم الدكتوراه في لندن. كيف انعكست بيئات الدراسة المختلفة على أسلوبكم النقدي والإبداعي؟
- قضية الأدب بدأت من نهاية المرحلة الابتدائيّة مع قراءة رواية الأم لغوركي، وبعدها مرحلة المتوسطة حيث روايات مثل عشاق فينيسيا وقصة مدينتين وروايات محفوظ وذنون أيوب، وتأتي المرحلة الثانوية لننهمك في قراءة الأدب الروسي المترجم والمسرحيات المترجمة، في ذلك الوقت كانت هناك االعربات والأكشاك التي تبيع الكتب العالمية المترجمة بسعر رخيص جدا يناسب مدخولنا الذي نأخذه من آبائنا، ولا تنس أيضا دَوْرَ الصرح العتيد مكتبة البصرة التي كان والدي يتردد عليها ويصحبني معه وجهود أمينها المرحوم محيي الذي زوّد المكتبة بقصص الأطفال والفتيان..
أما عن الدراسة الجامعية فأودّ أن أقول إنّ الدراسة في جامعة البصرة منحتنا زخما ثقافيا كبيرا، بخاصة في مجال الأدب والنقد والنقد الأدبي، كان في قسم اللغة العربيّة أستاذان كبيران يراعيان قضية الحداثة هما الدكتور زاهد العزي والدكتور حسن البياتي مؤسس القسم مع نازك. لقد صححت جامعة البصرة مساري الأدبي، أردت مرة أن أكتب بحثا في 15 صفحة في السنة الثانية فاخترت بحثا في اللغة (لهجة قبيلة بني أسد) فحذرني الدكتور حسن البياتي قائلا أنت شاعر وقاص (لا حظ خاطبني بما يبني شخصيتي بكل احترام) إذا تخصصت في اللغة تقضي على موهبتك، وأيده الدكتور زاهد العزّي، لذلك وقفت موقفا صحيحا أي كان اختياري حقل الأدب بدلا من اللغة، . الحق كان هناك أساتذة كبار في جامعة البصرة أمثال حسن البياتي وزاهد العزي وفؤاد معصوم الذي درّسنا علم المنطق، (الدكتور فؤاد أصبح فيما بعد رئيسا للجمهوريّة) وكان المنهج عظيما، ولا أغفل أيضا بعض الدكاترة الذين ثقافتهم صفر وهم قلّة والحمد للّه.
أمّا جامعة دمشق فقد فتحت لنا بابا جديدا في الانفتاح على النقد الأوروبي وعلم اللسانيّات اللذين كانا ضروريين لإكمال دراستنا العلميّة، في النقد الحديث والأدب المقارن كان هناك عميد السلك الدبلوماسي العربيّ المرحوم الدكتور حسام الخطيب، والدكتور المرحوم عبد الكريم اليافي الذي درّسنا علم الجمال فقد كنا نمر من قبل على مصطلحات مثل الحسن والرقة واللطف ولا نهتمّ بمعانيها، والدكتور عبد الكريم اليافي هو واضع أول نظريّة جماليّة في الأدب العربي، ويختلف مع الدكتور المرحوم مصطفى جواد في الخطأ الشائع وكتابه (قل ولا تقل) ويراه من باب الإزاحة على سبيل المثال كلمة صامد معناها الأصلي قاصد، والله الصمد أي المقصود بالعبادة لكننا عندنا الآن تعني الثابت، الشئ نفسه حدث في اللغات الأخرى مثل كلمة brave التي كانت تعني زمن شكسبير الجميل brave nights لكنها الآن تحمل معنى الشجاع وكذلك solicitor التي كانت تعني النشوة الجنسية للبغي الآن تعني المحامي المهم إنّ جامعة دمشق أخرجتنا من ببعض مخلّفات القوالب الجامدة بخاصة على يدي الدكتور أسعد عليّ في منحنا الحريّة المطلقة لنا في قول مانريد، ومثلما كان هناك أساتذة في جامعة البصرة لايفقهون وهم قلّة وجدنا مثل هؤلاء في جامعة دمشق وكانوا هم من ضمن القلّة. أمّا الدراسة في بريطانيا فأقول بصراحة إنّي حصلت على الدبلوم والماجستير في بلد عربي، لذلك يمكن أن تعدّ إكمال الدكتواره قضيّة شكليّة الإستفادة كانت من خلا دراستي للغة الدنماركيّة في كوبنهاغن واللغة الإنكليزية واحتكاكي بالمجتمعين ورغبتي في قراءة الأمثال والمصطلحات، والشعر والقصة الدنماركيّة والإنكليزيّة.
* بدأتم بالنشر المسرحي ثمّ تحوّلتم إلى الرواية والقصّة ما الذي أغواكم للانتقال من الخشبة إلى السرد؟
- هناك عدّة عوامل جعلتني أتأثر بالمسرح أوّلا، منها كثرة الكتب التي تباع في العربات، وعلى الأرصفة في شوارع البصرة، وكانت هناك سلسلة المسرح العالمي التي تأتينا من مصر، ثانيا وجود تلفزيون الكويت الذي كان يقدم باستمرار مسرحيات تشدّنا ومنها المسرحيات التي كان يقدّمها المرحوم عبد الحسين عبد الرضا، تعرف ذلك الوقت لم تكن هناك تقنية عالية لنشاهد عام 1965 تلفزيون بغداد. وصلنا تلفزيون بغداد بعام 1968 ثمّ تلفزيون البصرة وهما مسيّسان . يمكن أن تجلس ساعة يقرأ لك المذيع المرحوم رشدي المقال الافتتاحي لجربدة الثورة! لم نكن لنرغب فيهما - تلفزيون بغداد والبصرة-لذلك كانت أنتينات السطوح متجهة نحو الكويت، ثالثا الأفلام المصريّة، صحيح إنها ليست بمسرح لكنها تعتمد على الحوار والمشهد المتنقل الذي كنت أقارن بينه وبين المشهد المسرحي الثابت. في المدرسة الثانويّة حيث كتبت مسرحيّة عن العمل الفدائي بعد النكسة عام 1968، فمثلته المدرسة على مسرح بلدية البصرة وشجعني على الاستمرار في كتابة النص المسرحي المدرسون، ثمّ جاءت مرحلة جامعة البصرة التي درسنا فيها المسرحية اليونانية ضمن النقد الأوروبيّ، فكرتها والحوار فيها والمشهد وفلسفتها وطريقة الإلقاء وكونها شعيرة دينيّة، كنت مشدودا إلى مسرحيات أسخيلوس، سوفوكليس، ويوروبيدس، وسيل المسرحيات العالمية التي تأتينا مترجمة من مصر، فكتبت وأنا في المرحلة الثانوية والجامعية خمس مسرحيّات قصيرة طبعتها عام 1972 في كتاب عنوانه (الشاعر) وهو عنوان إحدى المسرحيّات الخمس، الكتاب صمم غلافه الفنان جواد الزبيدي الذي حصل على الدكتوراه فيما بعد وأصبح مخرجا وأستاذا في أكاديميّة الفنون، والذي قال عن المسرحيات إنها رائعة وقد قدمت نسخة من الكتاب للدكتور علي جواد الطاهر فقال لي إني بدأت بداية صحيحة وعليّ أن أستمرّ، لكن عندما سافرت خارج العراق وقصدت المغرب حدث تضارب بين روحي القلقة والمسرح. كنت قد صحبت معي ثلاثة دفاتر فيها ثلاث روايات هي المعبر، والمكتب والمختار، فازددت يقينا أنّي أحمل أعمالا هي أساسا للقراءة، العمل المسرحي وضع أساسا للتمثيل، حياتي ستكون متحركة لاتوصف قطّ بالثبات، اليوم هنا وغدا هناك، إضافة إلى أنّ الكاتب المسرحي غير حرّ في بدايته، الرّوائيّ يستطيع أن يبدأ روايته من أيّ مشهد، فالمسرح ثبات، وتقييد، وأنا بين الترحال، وحريّة الاختيار، إنّ الرواية والشِّعر أقرب إليّ، من أيّ فن أدبيّ آخر. قد يشدّني الحنين إلى الكتابة المسرحيّة في بعض الأحيان، هذا الحنين، جعلني أكتب بعض الروايات المهجّنة مثل رواية بهلول القصيرة، ورواية شئ ما في المستنقع التي تتألّف من فصلين الأول روائيّ، والثاني حواريّ، والثقافة المسرحيّة دفعتني إلى كتابة الرواية الموازية مثل رواية الصندوق الحديد، أو العتبات في رواية (الواقعيّة المستنيرة) كرواية الثامنة والنصف مساءً.
في روايات مثل (الشمس تقتحم مدينة الثلوج)، و(نهر جاسم) نجد حضورا قويّا للبيئة والمنفى، كيف تصنعون التوازن بين الحنين للوطن، ورؤية الواقع الجديد في المهجر؟
أنا بصفتي كاتبا أجد نفسي أمام ثلاث حالات: أحداث جرت وعشتها، وأحدث جرت ولم أعشها، وأحداث حاضرة. رواية. الأحداث التي عشتها التي جرت منذ الطفولة إلى زمن متأخز ومازالت راسخة في الذاكرة، تلك الأحداث التي ارتبطت بقضايا مهمة مثل قريتي ووجود المستر دوسن الإنكليزي فيها، و14 تموز ومجئ القوميين، والبعث، والحرب بين العراق وإيران، هذه الوقائع لايمكن أن أنساها لكني لم أستطع كتابتها في رواية مثل رواية (نهر جاسم) إلّا حين توفّر لي الاستقرار في الدنمارك فاستغرقت كتابتها أربع سنوات. أي الاستقرار والحريّة، مع ذلك تعرّضت لتشويه قليل، في أحد المشاهد بعد انقلاب 1968 هناك حوار بين البطل وصديقه: هذه المرة جاءووا ليبقوا مثلما هم باقون في سوريّة. الرواية طبعت في لبنان لكن الناشر له مصلحة تجاريّة في سورية، فخاف أن يقع عليه عقاب، فحذف هذه الجملة. وهناك أحداث جرت وأنا في الخارج فيمكن أن تكون هناك عدّة طرق أستقي منها المعلومات منها وسائل الإعلام : الصحافة والتلفاز، والأصدقاء أيضا لهم دور على سبيل المثال نهب المتحف العراقي، وتحطيم تمثال الدكتاتور، مشهدان رأيتهما في التلفاز الدنماركي بقيا مخزونين في الذاكرة، طالعت التاريخ ثمّ اتصلت بالصديق الصحفي السيد جمال هنداوي زوّدني بمعلومات عن تحطيم الجدار للمتحف ونهب بعض تحفه، وأسماء الشّوارع والتماثيل الأخرى التي عملتها المؤسسات التي كانت تتنافس في إرضاء الدكتاتور، كلّ هذه المعلومات كانت غائبة عنّي، عندما توفرت جاءت رواية (شولكي)، أما رواية الشمس تقتحم مدينة الثلوج، فهي تمثّل الحضور، أعني أنّها كُتِبت في حالة كوني بدأت أندمج بالمجتمع الدنماركي. كيف أستوعبه وبأيّة صورة. كيف أستفيد من أخطائه وحسناته، فهي رواية مهجرية. لأن أحد شخصيّاتها عربي والشخصيّات الأخرى دنماركيّة. لقد عبّرت الموجة المهجريّة الأولى عن معاناتها بالشعر، فحاولت الخروج عن هذه القاعدة. يجب أن يكون هناك استيعاب للمهجر بطريقة أخرى. زمن المهجريين الأوائل لم تكن هناك وسائل اتصالات متطوّرة نحن الآن عبر الهاتف والنت نكلّم يوميا أهلنا وأصدقاءنا يوميا، لقد تغيّر مفهوم الوطن في هذه المرحلة من أرض ومجتمع إلى صديق عزيز، الوطن أصبح بفضل التطوّر العلمي إنسانا تخاطبه وتراه كلّ يوم، فدرجة الحنين اختلفت، أمّا فيما يخصّني فأرى أن الرواية يمكن أن تستوعب هذا التحوّل النفسي أكثر من الشعر أو أيّ شكل أدبي آخر، فلو راودني الحنين للبلد الذي عشت فيه لرفعت الهاتف وتكلمت إلى قريب أو صديق، فأحسّ أنني هناك حيث تحوّلت الصداقة، والقرابة إلى بديل عن الوطن، أو لنقل الوطن أصبح إنسانا أكثر مما هو ذكريات، ونحن الذين بدأنا العيش في المهجر منذ سبعينيات القرن الماضي، كنا نشعر بالفرق مثل المهجريين الأوائل مبدعي الأدب المهجري حتى جاء النقّال والنت والكومبيوتر والستلايت، فأصبحنا نتعايش مع الوطن ونحن بعيدون عنه، ونتعايش مع المجتمع الجديد، في هذه الحالة لابدّ من الأدب الهجين الذي استطعت أن أكتبه على شكل سرد روائيّ.
* كتبتم أعمالاً من الخيال العلمي أيضًا. ماذا وجدتم في هذا النوع لم تجدوه في الرواية الواقعية؟
- الرواية الواقعيّة تعني محاكاة الواقع عن طريق السرد. طبعا المحاكاة لا تعني التقليد قطّ، بل استلهام الواقع، يرد في تعريف المأساة أنها تحاكي فعلا نبيلا تامّا، والمحاكاة التي أشار إليها التعريف القديم تختلف عن التقليد الحرفي، المحاكاة نفسها تنطبق على الرواية بالأخص الواقعيّة. والمحاكاة هي لما كان ولما هو كائن، أي الحاليّة، ولما يمكن أن يكون، وهي المستقبليّة أو المثالية، تصوّر مايكون عليه المستقبل.. أضرب مثلا لما كان برواية(الحبّ في زمن الكوليرا)، عن المحاكاة الحالية روايتي(كورونا) كتبتها في الأسبوع الأول من الوباء، والتي خصصت لها إحدى الجامعات الأردنيّة رسالة ماجستير، وهناك روايات أخرى تحاكي الحاضر مثل (النهر يلقي إليك بحجر وبعض الروايات القصيرة التي نشرت فصولا منها في صحيفة أوروك، نأتي إلى المحاكاة المثاليّة، أقول بصراحة وأنا في الصف السادس الابتدائي قرأت رواية (الأم)، وأعقبتها وأنا في المتوسطة رواىة الحرب والسلام، وروايات أخرى لبلزاك وغيره، كنت متشبّعا من الناحية الفنيّة بالروايات الواقعية ولا تنس القصص الخاصة بالأطفال والفتيان التي كنت أشتريها من المكتبات وأدمن قراءتها، عندما كبرت استفقت من حلم الواقعيّة وأثر الأدب الروسي الواقعي والفضل في ذلك يعود إلى دراستي الأكاديميّة، وأساتذة الجامعات اللذين شجّعونا على الحداثة وجماليّة النصوص، فتولّدت لديّ ردّة فعل إيجابيّة جاءت باتجاهين: الأول الخطّ الذي سمّيته الواقعيّة المستنيرة، ومن نماذجها (الساعة الثامنة والنصف) التي توازت مع التاريخ.. . عتبة من زمن النعمان بن المنذر، والعصر الحالي، و(الصندوق الحديد) التي يسبق كلّ فصل فيها عتبة من زمن ماض، و(أنا والشبيه) و(هو الذي منحني يدا) التي جاءت فيها سيرة الخطاط ابن مقلة موزعة على عتبات تسبق الفصول الخاصة ببطل الرواية الواقعي، لقد استحسن شيخ النقاد العراقيين البروفيسور عبد الرضا عليّ إطلاقي عنوان (الواقعيّة المستنيرة)، وبالتزامن مع هذه الأعمال سواء الواقعيّة أو الواقعيّة المستنيرة، التفت الناقد السوري المعروف الدكتور صالح الرزوق إلى المنهج الروائي الذي تدور ضمنه رواياتي فألّف كتابه عن تلك المحاولات الذي جاء بعنوان (الحساسيّة الجديدة في روايات قصي الشيخ عسكر) المطبوع في دمشق. أما الخط الثاني للخروج عن الواقعية التي تشبّعت بها وأنا في مرحلة الطفولة فقد جاء عن طريق روايات الخيال العلمي إذ سألت نفسي إن روايات الخيال العلمي تدور في الفضاء أو لنقل معظمها فجاءت أول رواية قصيرة عنوانها (آدم الجديد) التي تدور أحداثها على الأرض في محاكاة مثاليّة لما يمكن أن يكون عليه العالم في المستقبل، تتحدّث الرواية عن طبيب أمريكي، يجمّع خلايا لموتى في أزمان مختلفة وأماكن متفرّقة: الجزيرة العربيّة، الصين، فيتنام الولايات المتّحدة، الدنمارك، يجعل هذه الخلايا المخية الحيّة في جسد واحد، فيستفيق ذلك الإنسان ليجد نفسه متعددا يعيش في أزمان، ليتساءل ماسر هذ التناقض ومن هو. هذه الفكرة ربما -كما أخبرني بعض النقاد-قد تكون سُرِقت فيما بعد، لكن هذا لا يهم، وقد كتبت رواية هجينة قبلها طُبعت في دمشق، عن شخص يجد أجزاء جثّة في مستنقع فيجمعها وحين ينفض التراب عنها يجدها جثته هو، رواية (آدم الجديد) التي أقصد منها أن الولايات المتحدة تحاول إعادة تشكيل العالم على وفق ماترغب، ثم انفجار العالم على محاولتها تلك، جاءت في دراسة ضمن أطروحة دكتوراه في إحدى الجامعات الجزائريّة (جامعة الشاذلي بن جديد) للدكتورة الباحثة فتيحة عاشوري، كما ألّف عنها الباحث الناقد الأردني الدكتور عبد الرحيم مراشدة كتابا بعنوان (الرواية والمستقبل والنص الموازي) ثمّ جاء كتابه الثاني (تمثيلات التفاصيل في الرواية العربيّة) وهو كتاب يعالج فيه الرواية المعاصرة -محاكاة ماهو كائن- مثل رواية (نوتنغهام في علبة لشمانيا)، هذا الخطّ الروائي دفع أيضا الناقد المصري الكبير الدكتور يوسف نوفل لأن يدعمني في المضي للكتابة فيه فكتب لروايتين من رواياتي رواية (رسالة) التي يندمج بها الماضي والحاضر ورواية(النهر يلقي إليك بحجر) التي تحدثت فيها عن مأساة شط العرب، كتب مقدمتين لهما، وممن التفتوا إلى أسلوبي الروائيّ الجديد الدكتور المرحوم حسين سرمك الذي ألف كتابين عن روايتين لي هما كتاب (البطل البرئ) وكتاب (رسالة وجودنا) عن روايتي: (قصّة عائلة)و(رسالة).
* كتبتم الشعر بأنواعه المختلفة: العمودي، التفعيلي، وقصيدة النثر. أي شكل شعري وجدتموه الأقرب للتعبير عن همومكم الشخصية؟
- حبّ الرواية والقصّ ّتزامن مع حبّ الشعر. الآن البوصلة تميل للعمليّة السرديّة، قبل المدرسة حفظت أو جعلني والدي الشيخ عبد الرؤوف عسكر أحفظ الكثير من القصائد، وحين دخلت المدرسة، في زماننا كان هناك اصطفاف وطالب يقرأ قصيدة ثمّ يأمر المدير المعلمين باصطحابنا إلى الصفوف، لقد كنت ذلك التلميذ الذي يقرأ القصيدة، لا أتذكّر أيّ يوم من الأسبوع كان الاصطفاف الصباحي، وفي الأوّل المتوسط تعلّمت البحور الشّعريّة، أوّا بيت كتبته : كِلْمة قد قلتها منذ البداية أنا أهواك إلى مالا نهاية، وعندما أصبحت في الثالث المتوسط، كانت القصائد تحتشد في ذهني لكبار شعراء المعلقات، شعراء العصر الأموي بخاصة الفرزدق وجرير والمجنون، وبعض شعراء العصر العباسي، أوّل قصيدة كتبتها عن فلسطين عام 1967 بعد النكسة، جمعت فيها كلّ صنوف البلاغة من جناس وطباق، وكتبت قصائد أخرى.. . في المرحلة الجامعيّة اختلف الوضع، ملت إلى قصيدة التفعيلة لكن قصيدة العمود لم تتركني، الحالة هي التي تفرض النوع الشعري، ومازالت قصيدة العمود تفرض نفسها إلى الآن، بدأت بعد دراستي الجامعيّة أميل إلى قصيدة التفعيلة، وخلال دراستي الجامعيّة جذبتني قصيدة النثر. قصيدة النثر أحبّها قصيرة ببضعة أسطر لأنّها عندما تطول تصبح رتيبة،، إنّها تعتمد على الوشائج الخفيّة والعلاقات البعيدة بين الأشياء، فكلما كانت العلاقات التي تربط المشبه به والمشبه بعيدة في التشبيه والاستعارة كانت الصورة أبلغ، أنا لا أرى أن قصيدة النثر جديدة لأنّ العرب قبل الإسلام سموا الكلام الجميل المؤثر شعرا. القرآن ظنّوه شعرا أو فنّا من الشعر (وماهو بقول شاعر). أحيانا العقليّة العربيّة تزج بالنثر في الشعر مثل البيت المنسوب للإمام عليّ: أشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيكا كلمة أشدد زائدة، وهو التخزيم، والخزّامة زائدة، وهناك دخول حرف زائد على البحر الطويل مثل الواو، كان ذلك منذ قرون قبل أن يدخل أدونيس كلمات نثريّة في شعره، هناك زحف من النثر على الشعر جرى في الماضي، الشئ الوحيد الذي آسف له هو أنّ الغالبية العظمى من شعراء قصيدة النثر لايعرفون البحور الشعريّة، لنفترض لو قدّم لنا رجل لا يعرف القراءة والكتابة تمثالا رائعا أو ارتجل قصيدة جميلة ماذا نقول عنه، سنقول بالتأكيد نحّات فطري، أو شاعر فطريّ، لكننا لا يمكن أن نرفض نتاجا هو السائد في الساحة الآن، الكثير منه جيد والكثير منه ردئ، أمّا عن نفسي فأقول إنّ اللحظة الانفعالية هي التي تتحكّم بي ليكون ما أكتبه عمودا أم تفعيلة أم قصيدة نثر.
* وصفكم النقاد بأنكم تجمعون بين الشعر والفلسفة واللغة والبلاغة في نصوصكم. هل تشعرون أن الشاعر اليوم مطالب بأن يكون موسوعيًا؟
- هناك مقولة تخصّ الشعر أؤمن إيمانا مطلقا بها إنّ أي عمل أدبي لابدّ أن يضمّ في ثناياه خطرات فلسفيّة وأي عمل يخلو من التأمّل الفلسفي لا حياة فيه ويكون سطحيّا ولن يخلد. لا أقصد أن ننظم الفلسفة في الشعر مثلما فعل الزهاوي عندما تحدّث عن حركة النّجوم وكما يفعل بعض المتصوّفة. قد نتساءل لماذا خلدت على مدى الدهر معلقات طرفة وامرئ القيس وزهير وشعر المتنبي وشعر السياب لأن مفهوم تلك القصائد يعالج قضيّة الإنسان في الحب والفرح والحزن والسعادة والحياة والموت، قصيدة طرفة مثلا تعالج موضوع العبث الذي هو جانب من جوانب الفلسفة، كم كتب الشعراء في الحب، فنسينا قصائدهم وبقي شعر المجنون وكثّير عزة عالقا في أذهاننا. قصيدة السياب (المومس العمياء) تعبق بالخطرات الفلسفيّة، لابدّ أن يكون هناك توازن بين الشعر والفلسفة والبلاغة فلا يطغى أيّ من هذه الحقول، لو انفردت الموسيقى وحدها لكان الكلام سطحيّا، ولو طغت البلاغة لبدا الشعر مفتعلا، ولو تجلّت الفلسفة واضحة لأصبحت القصيدة نظما. الأساس هو الموهبة، لكن أرى من الضروري أن يكون الشاعر موسوعيّ الاطلاع لكي يبدع أكثر وتلك مسألة اختلفت فيها مع بعض النقاد الذين يرون أن ليس من الضرورة أن يعرف الشاعر لغة ثانية، ويحفظ الكثير من شعر الأسلاف، يكفي أن يعبّر عن تجربته من دون أيّة مؤثّرات خارجيّة.
* ماذا تعني لكم الموسيقى الداخلية في القصيدة؟ وهل تغير إحساسكم بالإيقاع بعد الغربة والكتابة بلغات أخرى؟
- الايقاع الداخلي والمناسبة بين الحروف، هي الثنائيّة التي ترتكز عليها القصيدة العموديّة، فعندما يمدح المتنبي شجاعة سيف الدولة : تمرّ بك الأبطال.. نجده يختار البحر الطويل المناسب للنفس الملحمي في الوقت نفسه يختار الكلمات القوية حرف الراء المنفجر والكاف.. وصيغة فعّال .. في قصيدة النثر يختفي الوزن وتبقى ثنائيّة الإيقاع وتناسب الحروف هي الأساس في التوافق مع الموضوع العام، إحساسي بالغربة وسرعة العصر هما اللذان دفعاني للكتابة في قصيدة النثر فالعصر سريع الوقع سرعته أثّرت في الأديب الشاعر الأوروبي منذ منتصف القرن الثامن عشر فبدأ بقصيدة النثر نحن جئنا متأخرين، الشاعر اليوم في أوروبا لا يكتب على وفق البحور إلّا نادرا. أمّا مايخص كتاباتي الإنكايزية فلدي مجموعة قصص قصيرة ورواية (كورونا)التي بالأساس كتبت باللغة العربية، ماكتبته باللغة الإنكليزية أردت منه التواصل مع الأديب والقارئ الإنكليزي.
* أنجزتم بحوثًا عن الأساطير والخرافات الجاهلية وأثرها في الديانات. ما الذي جذبكم إلى هذا العالم الرمزي؟
- عالم الطفولة كان متناغما مع القصص الشعبي والحكايات الخرافيّة وقصص الحوريات، إنّه عالم رائع يرتبط بالعظيمات وهنّ أميّ وخالتي، وحبوبتي زوجة خالي، أكثرهن قدرة خالتي، إلى درجة أنني كنت أظلّ صاحيا في الليل فأسمعها تقص وهي نائمة، ثمّ جاءت عظمة المسرحيّة اليونانية بأساطيرها الخالدة التي فسّرت الحياةومازالت تعيش فينا، فالأسطورة فيها بعض العلم والخرافة، والتأمّل الفلسفيّ. إضافة إلى نهايتها المأساويّة التي تهدف إلى تعليمنا. أسطورة أبي الهول مثلا ولغز الزمن: الإنسان يمشي على أربع ثم اثنين فثلاث، إن الاسطورة تعلمنا كيف نختار الخير ونتصرّف تصرّفا نبيلا بغض النظر عن النتيجة التي تواجهنا. إن لم تكن نفوسنا صافية فإنّ الوباء سينتهكنا كما تقول أسطورة أودب وتلك معان نبيلة نادت بها الأديان السماوية التي حذّرت من عقاب الربّ في الدنيا قبل الآخرة إذا أصبحنا أناسا سيئين.
* في "معجم الأساطير والخرافات الجاهلية"، هل كنتم تحاولون تقديم قراءة حديثة لتراث قديم، أم فقط جمعه وتصنيفه؟
- المعجم هو عمليّة جمع، وتبويب حسب الحروف الأبجديّة. استغرقت العمليّة أكثر من عشر سنوات. كلّما وجدت أسطورة أو حكاية خرافية دونتها، والسبب هو أنّني وجدت اليونانيين والرومان والهنود والصينيين، جمعوا أساطيرهم، ولم يفكّر أحد بجمع أساطيرنا قبل الإسلام، فكانت مصادري هي الشعر، والأمثال والخطب، وسجع الكهان، وكتب التراث القديمة. المعجم طبع في الأردن، أمّا الأمر الآخر وهو الدراسة فكانت عن الأساطير العربيّة قبل الإسلام- أي أساطير المعجم نفسه-وعلاقة تلك الأساطير بالديانات القديمة، العنوان هو أطروحة الدكتوراه، خذ مثلا أحد ملوك بابل، تجد في الأخبار البابلية القديمة وليست العربيّة أنّ الملك البابلي جدّد معابد آلهة العرب ومنها الإله رضا،، ألا يدلّ الخبر على وجود علاقة روحيّة بين البابليين والعرب في الجزيرة العربية. كذلك الأمر مع الهنود والفرس واليونانيين واليهود والمسيحيين، مما يدلّ على العلاقة الواسعة بين سكان الجزيرة العربيّة والشعوب الأخرى.
* ألقيتم محاضرات في جامعة دمشق وكوبنهاغن وأسهمتم في إعداد "معجم البابطين". كيف تنظرون إلى العلاقة بين الباحث الأكاديمي والمبدع الأدبي في شخصيتكم؟
- أتذكّر أوّل محاضرة لي في معهد كارستن نيبور في كوبنهاغن كانت بدعوة من صديقي المستشرق القس الأستاذ في المعهد نفسه سفن سونوغورد، كان عنوان المحاضرة (زمن الدائرة الشعريّة العربيّة) تحدثت فيها أنّ العرب قبل الإسلام يطلقون على كلّ كلام مؤثّر شعرا، بدليل أنّهم قالوا في بدء الدعوة عن القرآن شعرا، ثم انتهيت بقصيدة النثر التي جاءت بعد تطوّر هائل مرّ به الشعر العربي حتّى وصل إلى ماهو عليه الآن. كانت لي أكثر من محاضرة، ومنها محاضرة عن القصص الوصفي، لكن الحقّ أقول حمدا لله على أن لم أنصرف كلّيّا للتعليم الجامعي، لأنّ للتعليم لغة خاصة مباشرة، فضلا عن تصحيح الدفاتر والامتحانات، والعمل الروتيني، هناك الكثيرون من الموهوبين قتلهم البحث الأكاديمي العلمي لقد قرأت شعرا جميلا للناقد الكبير الدكتور عبد الرضا علي الذي رشّحني للتدريس في الجامعة الحرّة بهولندا فقلت له لقد ربحناك أستاذا وناقدا وخسرناك شاعرا، أنا نفسي جرّبت العمل في الصحافة اشتغلت مدّة عام مراسلا لصحيفة معروفة، كنت أخرج أتابع الأحداث، والأخبار، فكان يصعب عليّ أن أكتب قصة، لأنّ أسلوبي الطاغي وقتها أصبح أقرب للصحافة، واشتغلت في قناة كوبنهاغن القسم العربي، فخضعت للأسلوب الإعلامي، واحتجت إلى جهد لكي أعود قاصّا وشاعرا.
* يرى بعض النقاد أن لديكم "حساسية جديدة" في التعامل مع النص الروائي. كيف تفهمون مصطلح "الحساسية الجديدة"؟ وما الذي يعنيه لكم على مستوى الكتابة والقراءة؟
- مصطلح الحسّاسيّة الجديدة ابتكره الناقد السوري المعروف الدكتور صالح الرّزوق وقد ألّف كتابا عن رواياتي عنوانه (الحسّاسية الجديدة في روايات قصي الشيخ عسكر)، إذ عالج في الكتاب موضوع رواية المهجر وقضايا علم النفس، والبطل، والمجتمع، وقارن بين طريقتي وطرق الكتاب الآخرين العرب والأوروبيين، لأن الناقد الدكتور صالح الرزوق واسع الإطلاع شغوف بالقراءة النقديّة والرّوائيّة باللغتين العربية والإنكليزية، فما من رواية صدرت إلا وسارع في قرائتها إضافة إلى أنه قاص وكاتب روائي، ومترجم، وقد تتبع نتاجاتي منذ المرحلة الواقعيّة، فالمرحلة الضبابية أو الزرقاء كما أحب أن أسمّيها لأنني كتبت فيهما روايتين سجلتا حضور الماء هما (سيرة رجل في التحوّلات الأولى)و (شئ ما في المستنقع) ومرحلة الواقعيّة التي أستندت فيها إلى الاستفادة من التراث مثل(شهريار يهاجر للصمت المباح)و(آخر رحلة للسندباد)وأود أن أشير إلى أن المستشرقة الألمانيّةالمرحومة (Wiebke Walther) أستاذة الأدب العربي في جامعات ألمانيا قسم الاستشراق بعثت برسالة إلى الدكتور الباحث جليل العطية -موجودة نسخة منها -تعجب فيها باستلهامي التراث في قصصي، ورواياتي بشكل ملفت للنظر كما تقول، والواقعيّة الأنيقة (نهر جاسم) والواقعيّة المستنيرة(الثامنة والنصف) و(أنا والشبيه) و(هو الذي منحني يدا)
* ما الذي ظل ثابتًا في داخلكم رغم تغير المنافي والمدن؟
- عالم الطفولة، أوعالم قرية نهر جاسم، حيث ترقد خالتي جنبي تظلّ تحكي لي حتّى أغفو، أو أمي أو حبوبتي، هنّ اللائي زرعن حب القص والرواية في نفسي، ومدرسة التنومة الابتدائيّة، ومجالس رمضان في ذلك الوقت، وعاشوراء، كنا ننتظر 11 شهرا ليطلّ رمضان، و11 شهرا ليأتي عاشوراء فنقع على هذين الشهرين الجليلين بلهفة وشوق لهفة الظمآن للماء، هل يعلم أحد أنه يمكن أن ينسى أسماء مدرسيه في الجامعة والمرحلة الثانوية، ولا ينسى أسماء معلميه في الابتدائيّة؟ هذا هو العالم الذي لم يتغيّر في داخلي.
* لو طُلب منكم أن تختاروا كتابًا واحدًا من مؤلفاتكم ليكون "سفيركم الأدبي" للعالم، أي كتاب تختارون ولماذا؟
- بصراحة ومن دون تردد رواية (نهر جاسم) أوّل رواية كتبتها في مرحلة الواقعيّة الأنيقة. أضف إلى ذلك أنها غطت من الناحية الفنية مساحة واسعة امتدت من نهاية العهد الملكي إلى بداية الحرب العراقيّة الإيرانيّة، ويلاحظ القارئ والناقد أنّني جعلت قريتي الصغيرة تتفاعل مع مايجري في مدن كبيرة مثل بغداد وواشنطن وموسكو، والسبب الأهم بطلة الرواية القويّة الشخصيّة، حين قرأت ثلاثيّة محفوظ في الصف الثاني المتوسّط أشفقت على بطلة الرواية الضعيفة الشخصيّة أم فهمي وكمال، وقرفت من شخصيّة أم ياسين المنحلّة ولكوني نشأت في أحضان نساء قويات الأم والخالة وزوجة الخال، حتى المرأة التي أرضعتني -حين تضطر أمي لجلبي لها- كانت رحمها الله قوية، النساء الأربع القويات في حياتي دفعنني لأن أكتب رواية بطلتها قويّة الشخصيّة في زمن مضطرب قلق.
* هل ترون أن المغترب كاتبٌ دائم الترحال، حتى على مستوى اللغة والأسلوب؟
- ليس ضروريا أن يكون المغترب كاتبا، لكني أستطيع أن أصنّف المغتربين الذين يمارسون الكتابة إلى مجوعتين: مجموعة تكتب عن واقعها الجديد، ولاتنسى ذكرياتها القديمة، فهي تكتب عن الحاضر الجديد ولا تنسى الماضي، ومجموعة تعتمد على الذكريات فقط، ولا يهمها الحياة الجديدة في بيوت هؤلاء صحون فضائية يراقبون المحطات العربية، يتعلمون اللغة للاحتكاك بالمجتمع ولا يتفاعلون معه كتاباتهم عن الماضي فقط.
* النقاد الذين تراهم قدموا رؤية نقديّة موضوعيّة للأدب العربي؟
- الذين دفعوا الحركة النقديّة باتجاه الموضوعيّة والإبداع النقدي وجمعوا في الوقت نفسه بين الاحتراف الأكاديمي والنقد : من العراق: علي جواد الطاهر، عبد الرضا علي، صلاح نيازي، حسين سرمك، نجم عبد الله. الأردن عبدالرحيم مراشدة، من سورية صالح الرزوق، وقاسم المقداد، جورج طرابيشي، سمر روحي الفيصل، خالدة سعيد، نعيم اليافي، مصر: جابر عصفور، يوسف نوفل. أما مانقرؤه ونعايشه يوميا فهو يندرج ضمن انطباعات، ومقالات مزاجية فيها خطرات نقديّة.
* أين اضع نتاجك بين الأعمال العراقية المعاصرة وماذا استفدت من الرعيل المبكر: جبرا والتكرلي وعبد الرحمن مجيد الربيعي؟
- الحقّ قرأت غائب طعمة فرمان، الرائد ذنون أيوب، محمود السيد، جبرا أبراهيم جبرا. قرأت للروائي عبد الرحمن مجيد الربيعي أظن أكثر قراءاتي في الأدب العربي الروائي مصريّة وسوريّة حيث احتشدت في ذهني أسماء مثل عبد السلام العجيلي وفاضل السباعي وهاني الراهب وآخرين.
* مارأيك برواية الدكتاتور العراقية، وهل لها علاقة برواية الدكتاتور في أمريكا اللاتينيّة ولماذا لانقول عن رواية ستالين وهتلر إنّها عن دكتاتوريات تركت أثرا عميقا بالتاريخ العالمي؟
- في العراق صدرت روايات عن الدكتاتور فيما يشبه السيرة، مع الأسف لم أطّلع عليها لظروف ما، وأعتقد أن الكتاب العراقيين استوحوا رواياتهم عن الدكتاتور من رواية (ليس للجنرال من يكاتبه) وهو إبداع أمريكي لاتينيّ بحت، آمل أن أطلع على الروايات العراقية التي تحدّثت عن ذلك، أما عن الروايات التي كتبت عن هتلر وستالين فإن شخصيتيهما ارتبطت بالحرب العالمية الثانية ضمن حركتين متضادتين هما الفكر الشيوعي والنازي. هاتان الشخصيتان أوروبيتان وأوروبا لها رؤيتها الثقافية العامة وإبداعها النقدي ـأما الدكتاتور العربي واللاتيني فيبقى في إطار مجتمعه، لقد سمعت بيان الاستسلام الألماني الذي أذيع من الإذاعة وقتها فيه جملة: إن الفوهرر قتل وهو يدافع عن المانيا من البلشفيين. وع العلم إن الحرب بدت مع أوروبا الغربية من قبل ألمانيا وانتهت بتضحيات الروس.
***
حاوره جمال الهنداوي
....................
الحوار منشور في صحيفة اوروك ايضا