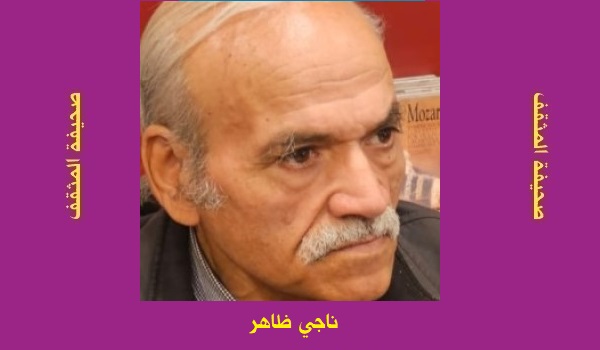قضايا
محمد سيف: من "الأمن" الفكري إلى "التمكين" الفكري!!

خلال زُهاء ربع قرن تبلور مفهوم (الأمن الفكري) على الصعيد الإعلامي وتبنّاه العمل المؤسسي العربي؛ نتيجة أحداث سياسية-أيديولوجية ولّدت ضغطًا هائلا؛ مما حدا بالسلطات العربية جرّاء تصاعد وتيرة هاجس الخوف من تأثير الأفكار التي تقوّض استقرار الدولة، لاتخاذ موقف هجومي في التصدي لهاته الأفكار التي لا تتماشى والخطَ الرسمي بِوأْدها في مهدها بعقلية أمنية، الأمر الذي يتعارض وبنيةَ الأفكار، ويتجاهل ما يخلّفه قمعها.
وفي ظل الانفتاح المعرفي الذي نشهده بات قارًا أنّ مفهوم (الأمن الفكري) بحاجة جادّة لإعادة تموضع ومراجعة أبعاده لينفض عنه غبار التعامي عن آليات إنتاج الأفكار، فيستحيل مفهوما مبنيا على أسس متينة، مستوعبا حيثيات استجابة الدماغ - وفق علم الأعصاب الإدراكي - للأفكار، وهذا ما يقترحه مفهوم (التمكين الفكري).
إنّ مغبّة (الأمن الفكري) تكمن في كون الممارسات التي يشرعنها تنسحب على عموم الأفكار ذات الجِدّة والفرادة، ما ينتج عنه تكميم روح التنوّع والإبداع؛ فتكون الدولة خِلْوًا إلا من نُسخ آمنة توافق السردية السائدة، وحيث إنّ ذلك يستحيل من حيث التكوين الدماغي، وخصوصا في خضمّ عالم يشهد انفتاحا واسعا على بعضه البعض، ووسط ظروف متداخلة شديدة التعقيد، فإنه سيفضي - ولا بُدّ - إلى تفشّي ظاهرة النفاق الفكري؛ تمهيدا لانفجارات قابلة لاحتضانها من أجندات مختلفة، وهو ما وُضِع مفهوم (الأمن الفكري) بادئ الأمر لأجل منع صيرورته!
وهُنا لا يمكننا إغفال طرح الفيلسوف الإيراني الفرنسي دارْيوش شايغان وغيره بكون الهُوية جذمورية الطبيعة، حيث تتفاعل الهوية مع محيطها في الوسط التعددي من غير أن تنفصل عن جذورها، وتؤثر من غير أن تفرض جذورها، مثل تفرع الجذمور تحت سطح الأرض، فلا تعرف لها بدْءا ولا انتهاء في شبكة متداخلة بالغة التشعّب، والتي تعني تنوّع أفكارٍ بالضرورة!
مع مفهوم (الأمن الفكري) تكتسب قائمة منتقاة من الثوابت المتوارثة حصانة منيعة ضد كل سؤال ونقاش، فتغدو الدولة زنزانةً معرفية يجرها الماضي إليه؛ فتخسر سباق الحاضر، ثم تكون مشرّدةً على رصيف المستقبل، غريبةً عن أسياده، ولإهماله طبيعة الأفكار الذي يغفل عن دراسة دوافع تبنّيها وكيفية تشكّلها دماغيا، فهذا المفهوم حتمًا سينشغل دومًا بمطاردة أعراض مآلات معالجته.
إنّ العقيدة الأمنية تعوزها الأدوات الفكرية الملائمة معرفيا؛ لذا فهي تتعامل مع الأفكار المضادة نسجًا على منوال تعاملها مع الأخطار المهددة للأمن العام؛ ولذا ترى أسلوب القمع والتغييب حاضرا بصرامة في معادلة الأمن والفكرة - مهما تفاوتت حدّته - إذْ ترى الفكرة التي لا تتساوق ومساحةَ المسموح مصدر تهديد يجب تحييده، والغاية تبرر الوسيلة!
فإذا كان ذلك كذلك؛ فإنّ الانزياح في التعاطي مع الأفكار على مستوى الدولة من (الأمن الفكري) إلى (التمكين الفكري) لا يقتصر على مستوى المفهوم، بل يتعداه إلى مؤسسة الاشتغال، ففي الوقت الذي كانت فيه المؤسسة الأمنية هي قطاع الاشتغال بـ (الأمن الفكري)، يجب أن يُناط بمؤسسة بطبيعة إنسانية ومعرفية صِرفة، إنفاذ (التمكين الفكري) وأن تؤول إليها اختصاصاته بما هي جهة تتمتع باستقلالية سلطوية وحصانة سيادية، وإلا وقعنا في الدَّور بسبب إكراهات النفوذ.
ذلك من ناحية التبعية، ومن ناحية التأصيل فإنه حتى ينضج مفهوم (التمكين الفكري) على النحو الذي يُراد له لا بد من مَأْسَسَتِه - بمعنى تحويله إلى نظام مؤسسي إنْ صحّ التعبير - بكادر مؤهل فكريا معيّن وفق معايير موضوعية تراعي نزاهة الانتماء للمصلحة العامة، على أنه يمكن أن يكون لهذه المؤسسة مراكز فكرية (Think Tanks) ممتدة وفقا للتوزيع الديموغرافي للسكان بما يلبّي أهدافها على أكمل وجه وأوسع نطاق.
هذا التأسيس يدفعنا لترسيم أبعاد (التمكين الفكري) حتى يتمايز عن سلفه (الأمن الفكري) في العمق والجذور؛ لِئلا يُنظر إليه على أنه محض مشاحّة في الاصطلاح، فماذا نعنيه فعلا بمفهوم (التمكين الفكري)؟
إنّ مفهوم (التمكين الفكري) في نطاقه العريض يعني تعزيز مبدأ حماية المجتمع من فكرة العنف في الاختلاف العقائدي، ذلك الاختلاف الذي يكون مبررًا مقززا لإلغاء الآخر معرفيا ومجتمعيا وجسديا، ويعني فيما يعنيه كذلك تعزيز البيئة الفكرية الصحية الحاضنة ليفكر الفرد فيها بصوت مسموع عن صراعاته الفكرية بأمان لا تعكّره أصوات التخوين والتكفير والإدانة والملاحقة والإسكات، فالمساحات التي تمكّن الفرد من مشاركة أفكاره علانية أقلّ عُرضة من أنْ تتحوّل إلى أقبية غاضبة سرّية، والفكر المتروك للتخمّر في الظل يتحوّل إلى خلايا محتقنة تنتهز أقرب فرصة مؤاتية لانفجارها؛ والذي ينتهي به المطاف - طال الزمن أو قصُر - لفاتورة باهظة تتحملها المؤسسة الأمنية كانت في غنى تام عنها.
كما أنّ مفهوم (التمكين الفكري) يسعى لرفع وعي المجتمع بألّا يغرق في اللاجدوى، والاستهلاك المفرط للمؤقت حيث تزدهر صناعة وعي استهلاكي هشّ لا نفع فيه، إذن (التمكين الفكري) الذي ننادي به يسعى لمناهضة السطحية بتفكيك الأُطر التي ترعاها، ويهيء البيئة الملائمة التي تحرّر العقول من السذاجة.
(التمكين الفكري) - على النقيض من (الأمن الفكري) - يدرك أن التحوّل المعرفي للفرد لا يعني مجرد تبديل رأي بآخر، بل هو تغيّر في النشاط العصبي في الدماغ، خصوصا داخل شبكة الوضع الافتراضي (Default Mode Network) المسؤولة عن تحوّل السردية الذاتية داخل الدماغ!
(التمكين الفكري) يعني التعاطي مع الأفكار بالفهم واستيعاب الدوافع، والتفكيك التحليلي، وإنتاج أفكار جادّة ذات فرادة، تُخاطِب الحاجة التي تستثير استجابة الدماغ؛ فيغدو (التمكين الفكري) فضاء احتواء تنمو فيه العقول لا مقبرة تُدفن فيها صرخاته وحديقة خلفية يُنتهك فيها عرضه، إنه بحق ساحة للدراسة في حقل علوم كعلم النفس الاجتماعي، ومن آثار ذلك الاحتفاء بالمفكرين عبر تمكينهم، فـ (التمكين الفكري) يركّز بشكل محوري على إعداد دراسات فكرية تُعنى بفحص اتجاهات الفكر السائدة وممكّناته في القُطر الواحد بصورة شمولية، بالإضافة إلى اقتراح سياسات مبنية على دراسات معمّقة، وتفكيك الظواهر المعقدة (غلوّ، تجييش عاطفي، تدافع فكري غير صحي…إلخ)، وتاليًا إنتاج معرفة تسبق القرار السياسي، وتعين صانع القرار على الانطلاق من أرض صُلبة، وتقديم معالجات رصينة بدل ردود الفعل المرتجلة وغير المسؤولة وغير محسوبة العواقب.
ويصحّ لنا أن نقول بملء الفم إنّ مفهوم (التمكين الفكري) ضرورة حوكمية من حيث هو تمكين التنوع، وليس وصاية بتحديد قائمة بالآراء المسموحة، إنه يعني الحثّ بصدق على (التفكير النقدي) المؤسس على نظرية المعرفة من حيث المبدأ، ورعاية سياجه الذي يضمن حرية ممارسته ويحرس حقوقه، لا أن تكون العقول مسكونة في قوالب ضيّقة وحبيسة التبعية باسم الحماية.
مِن ثَمّ؛ لعلنا يجب أن نتسالم مع فكرة أنّ الحقيقة ليست مطابقة دقيقة للواقع بقدر ما هي مُنتج سلطوي، وفق ما تعتبره الدولة - بمكوّناتها كافة - حقيقة، كما أبانَه ميشيل فوكو في نظام الخطاب، وفي سياق (الأمن الفكري) وسط التجاذبات الفكرية بين إرادة الدولة وميول الفرد الفكرية كثيرا ما يُصار إلى أساليب متعددة لحقن هذا المنتج السلطوي في الوعي الفردي كأسلوب ازدواجية التفكير (Doublethink) كما رفعت الحُجُب عنه رواية 1984 لجورج أورويل، إذ يُستبدل بإدراك تصور نقيضه، فتغدو - مثلا - العبودية الفكرية حريةً، إذْ تُقدّم على أنها ضرورة تنظيمية، في الوقت الذي تقتضي فيه طبيعة التفكير الواعي التحرر من العوامل المؤثرة غير الموضوعية حدّ المستطاع.
وقبل حوالي قرنين ونصف أطلقها كانط صرخة مدوّية في وجه العقل المؤمَّم (= الذي صار ملكية عامة): "تجرّأ أن تستخدم عقلك الخاص!" في مقاله: (الإجابة عن سؤال: ما التنوير؟!) بعد أن عرّف فيه التنوير بأنه خروج الإنسان من العجز الذي سبّبه لنفسه، العجز هو عدم القدرة على استخدام عقله دون توجيه من شخص آخر، كما نجد ديكارت في تأملات في الفلسفة الأولى منذ أربعة قرون من التناسل الفلسفي عمد بجرأة بالغة إلى آرائه فلم يكتف بالشك بل افترض بطلانها حتى يختبر حقيقتها بدون أحكام مسبقة في سبيل التحرر من أية رواسب تبعية.
إنه من السهولة بمكان أن يوظَّف مفهوم (الأمن الفكري) بشكل مائع، يدمّر أكثر مما يصلح، في حين ينتصب مفهوم (التمكين الفكري) أداةً صحية ووقائية مبكرة، لا تقفز على كُنْه الأفكار، ولا تستهين بعفاريتها الطائشة، ولا تجرّ المجتمع إلى عنق زجاجة يشظّي تطلّعاته وواقعه من قبل!
وختاما، لا الاجتماع البشري يستقيم بلا دولة تنظّم معيشته، ولا الدولة تنهض بأفراد غير ممكّنين فكريا؛ ومن هُنا يأتي (التمكين الفكري) مشروعا وطنيا بامتياز.
***
بقلم: محمـــد سيـــف