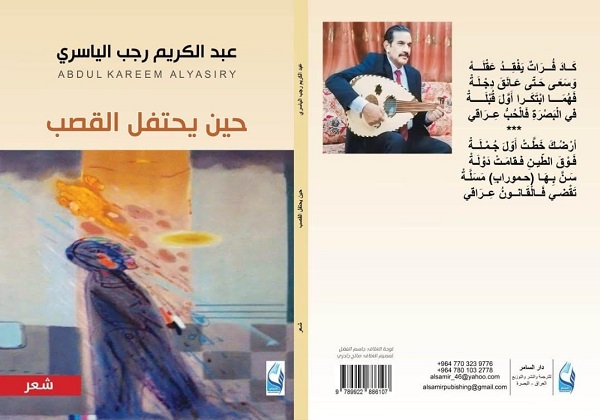قراءات نقدية
محمد المحسن: قراءة في مجموعة الروائي التونسي المحسن بن هنية "الزهرة.. والخريف"
 "وحده من يسأل هو الذي يعرف” (من محاورات سقراط للسـفاسـطة)
"وحده من يسأل هو الذي يعرف” (من محاورات سقراط للسـفاسـطة)
..حين يلج المحسن بن هنية عتبة الإبداع، ويؤثث حضوره في فضاء المبدعين، فإنما نراه يسعى-بجهد غير ملول–إلى أن يكون شاهدا على عصره وفاعلا فيه بالقدر الذي يحتمله واقع المنع والإباحة، لذلك فهو يجرنا –دون وعي منّا-إلى ذواتنا أو هو يذكرنا بها مشروخة مشظاة
ولا عجب فيما أزعم إذا علمنا أن هذا القاص جاء إلى القصة القصيرة من أبواب الحياة الشاسعة، وراح يؤثث فضاء لغتها بالمجاز وبالإستعارة ذات الكثافة الحسية، والتوتر والإيحاء مما ساهم في إيجاد مناخات عالم قصصه المعبرة عن علاقة شخوصه المختلفة والمتوترة مع الذات والعالم الذي يتركها لمصيرها الأعزل وحيدة ضائعة، مستلبة ومقهورة بسبب الشرط الإجتماعي والوجودي المأسوي الذي تحياه، والذي يجعلها تنكفئ على دواخلها – المعطوبة – وتعيش في مناخ كابوسي مخيف لا تجد سوى الأحلام وسيلة للهرب، وإشباع رغباتها المستفزة والمحرومة .
لم يضق الكاتب بأشكال الكتابة القارة ومرجعياتها، ويعمل على تهديمها لإحساسه بالضيق بها، وتأكيده لقيمة الحرية كشرط للإبداع الأصيل، وإنما عبر أيضا عن ضيقه بالواقع، ونقمته عليه، وتمرده على مواضعاتها الأخلاقية والإجتماعية، وفضح مظاهر الترجرج والسقوط والقهر فيه، ولذلك حاول أن يصور ذلك الواقع بالقسوة التي كان يراها فيه، أو يرى مأساة الإنسان وضياعه تتمثل فيها.
إن قراءة تجربة القاص منذ عمله القصصي الأول “القمر لا يموت” الذي صدرفي عام 2000، وحتى عمله الاخير”الزهرة و الخريف” الذي صدر في عام 2003، تكشف أن هذه التجربة ظلت مخلصة لوعيها وقيمتها الفكرية والجمالية، وأنها رغم سعيها الحثيث للتأسيس للحداثة في القصة القصيرة، وقيمها الإبداعية والفكرية وأدواتها التعبيرية، والفنية، عملت كذلك على تمثل البنية الحكائية في التراث الشعبي العربي، وإعادة توظيفه في البنية السردية الجديدة باعتباره جزءا من نسجه العضوي ولذلك بدا واضحا في بعض أقاصيصه اشتغاله على الفنتازي الغرائبي و الحكائي دون أن يكون ذلك سمة خاصة بعالم المحسن بن هنية القصصي.
قد يذهب –البعض منا–في قراءته لتجربة القاص إلى أنّه رغم خروجه على أدب الإديولوجيا، كان ينطلق في بناء عالم قصصه من رؤية ايديولوجية تتمثل في تلك السمات المتناقضة التي تحكم عالم الصراع في الواقع، وتحدد أبعاده في أغلب نتاجه، لكن هذه الرؤية/القراءة سوف تتجاهل الدلالات الواسعة التي منحها القاص لمضمون الصراع وشكله ومستوياته، وإنه كان يعبر فيما يكتبه عن انحياز واضح لقيم الحرية والجمال والحب والتجدد، وإن قضيته الأساس ظلت تتمثل في اصطدام وعيه بالواقع الإجتماعي في مختلف تداعياته، كما أنه مازال يجتهد في فضح وتعرية الواقع من الداخل والخارج بقسوة أو سخرية لاذعة ومريرة، تنتصر للقيم التي آمن بها.
وإذا كان- البعض منا-كذلك يرى ميل التجربة إلى نوع من التنميط في أشكال تعبيرها، وبنيتها الحكائية، وفي مناخاتها..فإن هذه الرؤية تتجاهل بدورها التحولات الداخلية التي تحدث في شكل التجربة ومضمونها، كما أنها – تتجاهل– أن القاص كأي ّ مبدع أسّس لتحول جديد في كتابة القصة، مكّنه من أن يبلور ملامح تجربة تحمل سماته الإبداعية الخاصة، وبالتالي فإن التحوّل يبقى من داخل هذه التجربة التّي ترسّخت، وهو تحول تفرضه وتستدعيه حدود التجربة المنفتحة على الواقع وعلى رؤيته التّي تتنامى إلى الذات والعالم في جدل العلاقة القائم بينهما.
في مصافحتنا لهذه المجموعة القصصية (الزهرة و الخريف) يتبادر إلى ذهننا أنّ سيدي بوزيد هي الفضاء المكاني المتوقع لصياغة مضامين هذه النصوص، بإعتبار وأنّ القاص أصيل هذه الجهة المتخمة بالمبدعين، إلاّ أنّ فضاءه المكاني ظلّ في حدوده الأوسع لايحيل إلى مرجعية واقعية محددة، نظرا للدور الذي يلعبه عنصر التخييل في بنائه، وقد أعطاه ذلك طابعا تجريديا ومجازيا، يتناسب مع خصوصية البناء السردي الحكائي للقاص والذي يميل في الغالب إلى الإقتصاد الواضح في اللغة، وقد ساهم هذا الميل للإقتصاد في اللغة، واعتماد التكثيف الشديد والمجاز في تبلور ملامح القصة القصيرة عند القاص، الذي تميز في كتابتها، وساهم في تحديد عناصرها وهي التكثيف الشديد والإيجاز من خلال اللغة الشعرية الموحية، ولكن قراءة هذه القصص تحتاج إلى مشاركة جدّية من القارئ للقبض على معناها الدلالي الذي يتخفى وراء مجازية اللغة ورمزها، فالقاص الذي لم يتعب من الحفر في قاع شخوصه، وفي قاع الواقع يسعى من خلال هذا البناء الخاص للغته إلى دفع القارئ للمشاركة في إكمال القصّة، والحفر فيها للكشف عن مغزاها، ودلالاتها الثاوية وراء قناع اللغة التي أخذت في أعماله الأخيرة تتميز بتراجع المستوى الشعري فيها لصالح السرد الحكائي المكثف، بالإضافة إلى وضوح أسلوبه التهكّمي الساخر، وتعتبر أغلب قصص هذه المجموعة “الزهرة والخريف”خير مثال على ذلك، وفيها يبدو الكاتب فضائحيا وساخرا بامتياز إذ يخصص كما أسلفنا عددا كبيرا من قصص المجموعة للسخرية من مفارقات الواقع الإجتماعية والأخلاقية .
اللعبة السردية عند المحسن بن هنية:
الراوي الذي يتحدّث إلينا في هذه القصص شخصية متخيلة، لا تكاد تختلف عن أي شخصية من الشخصيات المتخيلة التي تعرضها علينا القصة، الإختلاف الجوهري الوحيد أنّ حضور شخصية الراوي في قصة – المحسن بن هنية – حضور محوري، يتغلغل في دقائق النسيج الذي تتألّف منه القصة، ونستمع إلى صوته وملاحظاته عند كل منحى، إلى الحد الذي تصبح معه القصة وراويها المحدث أمرين متلازمين، لا وجود لأحدهما ولا معنى دون وجود الآخر .
ليس لكلمة “القارئ ” أو “القراء” التي رأيناها كثيرا في كتابات – بعض الكبار – أمثال طه حسين أي ذكر على الإطلاق في قصص المحسن بن هنية، ومع ذلك فحضورنا – نحن القراء– حضور فادح في عالمه القصصي . هناك خطاب ضمني موجه إلينا على الدوام، نستشعره في كل كلمة وكلّ جملة، ولا ندرك كنهه أو سرّه في القراءة العجلى، ولكننا سرعان ما نكتشف أنّه ليس مجرّد خطاب ضمني غامض، بل خطاب صريح له شواهده اللغوية التّي لا تخطئها العين، وأبرز هذه الشواهد ضمائر الخطاب التي تتخلّل بعض الجمل وضمائر جماعة المتكلمين التّي تضمنا مع الرّاوي في صحبة واحدة وإزاء متعة ومسؤولية مشتركة.
صحيح أنّ الراوي في هذه القصص نادرا ما يكون شخصية رسمية من شخصيات القصة، يروي قصتها هي بضمير المتكلّم، أي أنه نادرا ما يكون راويا مشاركا في الحدث، لكنه أيضا لم يكن صورة من المؤلف المحسن بن هنية، إنه راو مراقب في الغالب، يشترك في بعض الأحداث بشكل طفيف، لكن دوره يتجاوز كثيرا دور المراقب التقليدي، لأنه أولا – يوجّه خطابه إلينا، ويهتم اهتماما بالغا، بإقناعنا وتشويقنا، ولأنه ثانيا –يشركنا بعمق وحرارة الرؤية والإكتشاف، فنصبح وكأنّنا نحن الذين رأينا واكتشفنا.
نحن والراوي شركاء في الرؤية والإكتشاف والراوي في قصته يبدو على نفس درجة الدهشة والتشوق التّي تعترينا.هذا التراوح بين وجود الراوي داخل القصة، الذي يقترب أحيانا من حضور المؤلف بشخصه على مسرح القصة، وبين وجوده خارج القصة يلعب دور المراقب . وذلك التردد الذي ينتاب القارئ في إدراكه لحضور الراوي :بين المرور النائم الغافل عن صوت الراوي المحدث، والمستغرق في حرارة القصة المشوقة من ناحية، وبين إدراك الفادح للشواهد اللغوية الدالة على حضوره من ناحية أخرى –هذا التراوح و ذلك التردد هما سرّ اللعبة السردية عند المحسن بن هنية.. لعبة “الحديث” المركبة هذه، هي جوهر السرد عند هذا القاص، والعنصر التكويني المطرد في كل ابداعاته تقريبا، خاصة قصصه القصيرة، على اختلاف تنويعاتها، لكن ما ميّز قصص هذه المجموعة، ليس الحبكة الكلاسيكية المعروفة، ولا نوعية الحوادث والشخوص التّي يختارها، ولا نوعية اللغة التّي يستخدمها فحسب، بل إن ما ميز هذه القصص قبل هذا وكله وفوق هذا وكله، هو صوت الرّاوي المحدث، قد تختلف أبنية هذه القصص: من الأحداث المختزلة، إلى الحكايات الإستطرادية المطولة، إلى نموذج القصص التحليلي، إلى نموذج القصص الشيكوفية ذات النهاية المفاجئة والمريرة في سخريتها…إلخ.
ليس لهذه القصص شكل واحد، أو حبكة وحيدة تخضع لنموذج مسبق، فالنموذج الوحيد الذي تخضع له كلّ هذه القصص تقريبا هو طريقة الحكي المخصوصة هذه، وما قد ينتج عنها من بنية واختيار خاص لنوعية الحوادث والشخوص واللغة .
لقد تناول المحسن بن هنية في هذه المجموعة موضوعات متباينة، وبيئات متتعددة وشخوصا من مستويات طبقية ومراحل عمرية متنوّعة (المعدم – السائحة الأجنبية –الكهل– التاجر– الجندي المقاتل… إلخ) لكنك حين تقرأ هذه القصص المتنوعة تشعر أنك إزاء رواية كبيرة متعددة الفصول، أو ملحمة متعددة الحلقات، يقف على رأسها هذا الرّاوي المتحدّث بطريقته المخصوصة في الحكي.
من المؤكد أنّ الرّاوي عموما، أو الوسيط الذي ينقل الحكاية إلى القارئ، أمر بالغ الأهمية في كل سرد، بل إنه سمة نوعية تميّز السرد عن غيره من أنواع الأدب، هذا ما يؤكده شتانزيل، الذي يؤكد ايضا أنّ كلّ ابتكار في فن السرد عبر التاريخ، وأنّ كلّ الروايات الكبرى– من ترسترام شاندي إلى يوليسيز..إلخ قد أولت عناية خاصة لهذا الوسيط الناقل للحكاية . وركزت كل ابتكارها فيه . غير أن لكل كاتب طريقته في العناية بالراوي أو الناقل أو الوسيط. وليست مسألة الراوي مجرّد مسألة من مسائل الشكل يعنى بها الناقد الشكليون أو علماء السرد، بل هي عنصر من أهم عناصر السرد الحاملة للمعنى بذاتها، إنّها العنصر المرن المراوغ الذي يقف على الحدود بين العالم الأدبي المتخيل داخل القصة، والعالم السياسي الإجتماعي الثقافي خارج القصة.
على سبيل الخاتمة:
إن إخلاص المحسن بن هنية لتجربته قد منحه الحضور الخاص وأعطى تجربته أهميتها، ولكن ذلك لا يمنع من القول إنّ هذا العمل القصصي الأخير (الزهرة والخريف) اتّسم على العكس من أعماله الأولى بعدم الإهتمام كثيرا بالبنية الدرامية للقص السردي وبوجهة النظر، وظهر لديه الميل الواضح إلى التركيز على الطابع الحكائي الموجز، وعلى عنصر المفارقة والسخرية والتهكم، لأن القاص بدا مهتما بالفكرة أكثر من اهتمامه بالجوانب الفنية والدرامية وبأبعاد الشخصية، وربما يكون –التصاقه الحميم بطين الأرض– قد ساهم في إيجاد هذه الحالة النابعة من التفاعل الحي والمباشر من الواقح.. إلاّ أن ذلك لا يمنع من التأكيد في المقابل على تجدد رؤيته، وسعيه لأنّ يتمثّل إيقاع الحياة وإشكالاتها وقضاياها المعاصرة التّي زادت من تعقيد أزمة الواقع ومن غربة الإنسان وضياعه، وضياع قيمه النبيلة لاسيما بعد أن غدا العالم كله مفتوحا على بعضه ومختزلا في شكل قرية كونية صغيرة..
محمد المحسن - ناقد تونسي