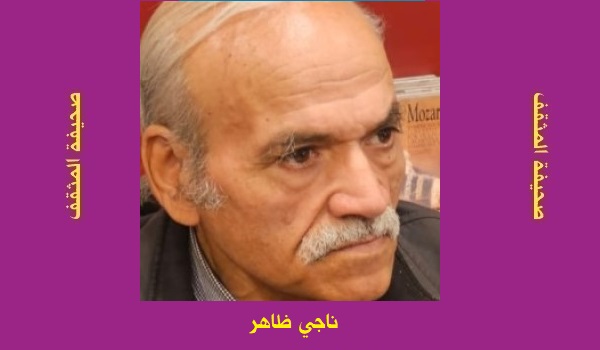أقلام فكرية
غزلان زينون: لسانيات من أجل التنمية الاجتماعية

1.مقدمة في اللسانيات التنموية
1.1. نظرة استكشافية: يقول جان بول سارتر" الإنسان هو اللغة، إن الإنسانَ هو أولا ما يقولُه"،[1] لكن اللغة تتعدى هذه المقولة وتتعدى بذلك كونها تعبيرا عن الفكر أو وسيلة للتواصل إلى كونها وسيلة الحركة الإنسانية كلها، سواء تعلق الأمر بالمجال العلمي، الاجتماعي، التربوي، الاقتصادي، أو السياسي، فاللغة وعاء ذلك كله ووسيلة ذلك كله، وإذا تراجعت اللغة توقفت الحركة الإنسانية وتوقف معها الاتصال والتواصل بل وحتى التفاهم، حتى لو كان بإمكاننا تصور مجتمع بدون نظام لغوي فلا يمكننا تصور وضع راهن لمجتمع بدون مراكز بحث وعلوم ومؤسسات تعليمية ووسائل اتصال ومعاملات بنكية وتجارية... ولا يمكن تحقيق أي من هذه الأنشطة بدون لغة، مادام التطور والتقدم مرتبط بالناس فإن المساهمة التي يطلب منهم تقديمها هي من خلال المشاركة في التواصل ونشر المعلومات وتبادل المعرفة والتغذية الراجعة واكتساب المهارات، وما ينبغي ملاحظته هو أنه عندما ينظر إلى الأسباب التي تؤدي إلى الفشل في تحقيق أهداف التنمية لا يتم ذكر اللغة كعامل مساهم بل يُنظر إلى التنمية من منظور ضيق يرتبط بما هو اجتماعي واقتصادي مع إهمال العامل البشري، فاللغة هي الحلقة المفقودة في محاولات النهوض بالمجتمعات البشرية. وهذا ما يجعلنا نتساءل: كيف يمكن للغة أن تساهم في تحقيق التنمية؟ - وما دور اللغوي في ذلك؟
1.1.1.نظرة في المصطلح
- مفهوم اللسانيات
تعد اللسانيات la linguistique من العلوم المستحدثة، حيث يوثق لظهورها بداية القرن العشرين، ورغم ذلك احتلت مكانة كبيرة في حقل العلوم الإنسانية، أطلق عليها العرب عدة تسميات من قبيل: اللسانيات، اللّسنِيات، الألسنية، وعلم اللغة العام، وفقه اللغة، وعلم اللغة، وهي تسميات لمصطلح واحد أخذ جذره اللغوي من مادة لسن، و"اللسن الكلام ولاسنه ناطقه"[2]. يعرفها الحليلي" أنها العلمُ الذي يدرس اللغات الطبيعية الإنسانية في ذاتها، مكتوبةً أو منطوقة كانت أم منطوقة فقط ... وتهدف إلى وصف وتفسير أبنية هذه اللغات واستخراج القواعد العامة المشتركة بينها والقواعد الخاصة التي تضبط العلاقات بين العناصر المؤلفة لكل لغة على حدة[3]، هذا التحديد لا ينفي انشغال العلماء والفلاسفة قديما باللغة غير أن انشغالهم هذا كان مجرد انطباعات حول اللغة أخذت صفتها العلمية مع ظهور لسانيات دو سوسير التي شكلت مهد الدراسات اللغوية التي سادت في أوروبا وأمريكا بكل اتجاهاتها إلى حدود يومنا هذا، وحسب الحليلي لا ينظر إلى موضوع اللسانيات على أنه اللغة بمعناها العام أي الملكة اللغوية والقدرة على اللغو بغض النظر عن العرق والجنس والمجتمع، وإنما هو اللسانla langue ذلك النسق من القواعد المجردة العامة المشتركة بين المتكلمين داخل مجتمع واحد.[4] وهذا إن دل فإنما يدل على أن أصل اللغة عند الأفراد نابع من طبيعتهم الاجتماعية التي تلازمهم، ومن حاجاتهم إلى التواصل مع الأخر.
-مفهوم التنمية
جاء مفهوم التنمية في المعاجم العربية بمعنى الارتفاع والزيادة،[5] وارتبط هذا التعريف بالمعنى الاصطلاحي أيضا، فتعلق حصرا بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، فكانت العناصر المادية هي المحدد الأساس للتنمية، لكن لاحقا اتسعت الرؤية بخصوص هذا المفهوم وأصبحت أكثر شمولية، فعندما تُحدد التنميةُ بدقة بحيث ترتبط بنمو الإنتاج وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي أو الدخل الفردي وتوزيع الثروات والاستثمارات الأجنبية، فنحن هنا أمام وضع يسمى" بالنمو الاقتصادي" وليس" التنمية الاقتصادية"، لأن الوضع الأول مرتبط بالقيمة والسلع والخدمات، بينما الوضع الثاني يرتبط برفاهية المواطنين، بحيث من الممكن تحقيق نمو اقتصادي دون تنمية اقتصادية، فقد تُسجِّل دولةٌ ما ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي بينما يعيش أفرادها في فقر مدقع، لكن لا يمكن إنكار أن النمو الاقتصادي أحدُ جوانب عملية التنمية المستدامة، فهذه الأخيرة هي الغاية بينما النمو الاقتصادي مجرد وسيلة.[6]
إن التنمية الحقيقية ينبغي أن تهدف إلى التحقيق الكامل للإمكانات البشرية وتوظيف موارد الأمة لصالح الجميع، فالتنمية سواء كانت محددة بشكل ضيق أو واسع لا يمكن تحقيقها ما لم ينخرط الجميع في عملية التنمية، وهذا الانخراط يتطلب حتما قدرة الناس على الوصول إلى بعضهم البعض، لذلك يمكننا ربط مفهوم التنمية بالنقط التالية:[7]
الاهتمام بتطوير المجتمع يبدأ من تطوير الفرد.
ترتبط التنمية الشاملة للأمة بمشاركة أكبر قدر من الناس خاصة الأكثر حرمانا.
يُفهم مفهوم التنمية على أنه عملية شاملة تسمح للسكان بتحقيق رفاهية ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل أيضا في المجالات ذات الأولوية كالصحة والأمن الغذائي والتعليم والبيئة...
رغم تعقد الأوضاع الاجتماعية في المجتمعات الفقيرة إلا أن التراث اللغوي إذا ما توفرت له الإدارة المناسبة يلعب دوره في دعم التنمية بهدف تحقيق قدر معين من الاستدامة.
خلق المعرفة وتداولها وتقاسمها عوامل تسهم في التقدم.
المدرسة ليست المكان الوحيد لتعزيز اللغات الهوية.
أ-مؤشرات تقييم التنمية
باعتبار التنمية هي التحسين المستدام لشروط حياة السكان على جميع المستويات، تم وضع مؤشر للتنمية يتألف من المعايير التالية: [8]
مستوى الرعاية الصحية، ويشمل أمد الحياة ونسب وفيات الأطفال.
المستوى الثقافي والتعليمي، ويحدد على أساس نسبتي التمدرس والأمية.
مستوى الدخل الفردي الذي يساوي حاصل قسمة الناتج الوطني الخام على عدد السكان، وفي ارتباط التنمية بالمؤشر الأخير فهي بذلك تتخذ أبعادا اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية.
ويُعتمد في دراسة التنمية على مقاربات عدة من قبيل:[9]
المقاربة الاجتماعية: وتقوم على مؤشرات اجتماعية مثل: نسبة الفقر والأمية والتأطير الطبي.
المقاربة الديمغرافية: وتقوم على مؤشر نسبة الولادات والوفيات والتكاثر الطبيعي.
المقاربة السياسية: تعتمد التنمية السياسية، على مستوى الديمقراطية وحقوق الإنسان خاصة في الدول النامية.
المقاربة البيئية: تركز على مراعاة البعد البيئي في مخططات التنمية.
ب- أنواع التنمية
لقد كان مفهوم التنمية- منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية عقدِ الثمانينات- قاصرًا على كمية ما يحصل عليه الفرد من سلع وخدمات مادية، ولكن مع تدشين مفهوم التنمية البشرية عام (1990) عندما تبناه برنامج الأمم المتحدة للإنماء، أصبح الإنسان هو صانع التنمية وهدفها. فصار الحديث يتناسل عن المؤشرات الجديدة على هذا المفهوم، وكيف السبيل إلى تحقيق جودة حياة لهذا الإنسان، من خلال الارتقاء بمستويات عيشه المادية والمعنوية في توازن مع محيطه وثقافته وتاريخه ولغته.[10] إن التنميةَ مفهوم واسع يشمل جوانب متعددة تتعلق بتطوير المجتمعات والارتقاء بجودة حياة الأفراد، ويمكن التمييز فيه بين ثلاثة أنواع:
التنمية الشاملة: التي تركز على جميع جوانب حياة الأفراد، فهي عبارة عن عملية مجتمعية تهدف إلى إيجاد مجموعة من التحوّلات الهيكلية وذلك بتوجيه جهود الأفراد الواعية وتسخيرها عبر تحفيز الطاقة الإنتاجية لديهم من خلال تحقيق الحياة الكريمة والعيش برفاهية عبر التعليم والصحة والتركيز على جميع طبقات المجتمع، وفتح آفاق أمام المرأة للانخراط في كافة مجالات الحياة وتعزيز مفاهيم الثقافة الوطنية.[11]
التنمية المستدامة: ظهر هذا المصطلح مع الحاجة إلى تصور نموذج مجتمعي قادر على بلوغ اندماج ثلاث مكونات هي: التنمية الاقتصادية واحترام حقوق الإنسان وحسن تدبير موارد طبيعية محدودة، ترجع جذورُه إلى القرن التاسع عشر حيث تزامنت من الانشغالات الأولية بالبيئة والمناخ، لاحقا ومع توالي الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية- خلال القرن العشرين- سيتم إرساء المفهوم بشكل رسمي خلال قمة الأرض ريو(1992)، وتسعى التنمية المستدامة إلى تلبية احتياجات البشر في الوقت الراهن دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تحقيق أهدافها،[12] كما تركز على ثلاث دعامات، هي: النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والجودة البيئية،[13] ففي 20 شتنبر (2010) اعتمدت قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة قرارا بعنوان" تحويل عالمنا: جدول أعمال (2030) للتنمية المستدامة شمل 17 هدفا و 169 غاية، يمكن تلخيصها إلى ثلاثة أهداف كبرى:[14]
الاستدامة البشرية: تهدف إلى تطوير قدرات الإنسان لخدمة نفسه ومجتمعه من خلال تحسين الظروف التعليمية والثقافية والصحية، وإشباع حاجياته المادية والروحية والمعنوية لضمان دوره الفعال في عجلة الاقتصاد والمجتمع والبيئة.
الاستدامة البيئية: تهدف إلى الارتقاء بالبيئة وحماية عناصرها ومكوناتها عبر التعريف بهذه الأخيرة والتحسيس بأهمية التأثريات البيئية على مختلف الكائنات الحية، والتعاون بين الدول لترشيد الاستهلاك والاكتظاظ السكاني والتحكم البيئي.[15]
الاستدامة الاقتصادية: تهدف إلى زيادة الدخل الوطني وتحسين مستوى المعيشة وتقليل التفاوت في الدخل والثروات وبناء الأساس المادي للتقدم.
التنمية البشرية: مفهوم التنمية البشرية يستند إلى الإنسان وتكون غايته الإنسان، فهدف التنمية البشرية هو تنمية الإنسان فيمجتمع ما، من كل النواحي: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلميةوالفكرية، يُعرّف هذا المفهوم على أنه تطوّر الأشخاص واستغلالُ نقاط القوة لديهم لتحسين مستويات الحياة الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، من حيث تحفيز وتعليم الإنسان كيفية استثمار العناصر المتاحة من وقت ومال وجهد وعلاقات لتطبيق نظرية التطور الاجتماعي التي تعطي للإنسان قيمة وأهمية باعتباره العنصرَ الفاعل والأبرزَ في عملية التطور، إضافة إلى أهمية تحقيق المواءمة بين احتياجات الإنسان ومتطلباته وبين الظروف المحيطة به على الصعيدين المادي والمعنوي ومدى التأثير المتبادل بينهما.[16]
أخلُص من خلال هذا الفصل إلى أن التنمية الشاملة عملية تنموية متكاملة تستهدف جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لتحقيق النمو والتقدم المتوازن؛ تسعى إلى تحسين مستوى المعيشة في جميع المجالات دون ترك أي جانب متخلف، بينما التنمية المستدامة تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة. تعتمد على مبدأ الاستدامة، أي تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، أما التنمية البشرية فتركز على تحسين القدرات الفردية مما يمكن الأفراد من المشاركة الفعالة في عملية التنمية. تُعتبر العنصر الأساس في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. بعبارة أخرى، التنمية الشاملة تهتم بجميع القطاعات، والتنمية المستدامة تُراعي الحفاظ على الموارد، والتنمية البشرية تُركز على الإنسان كمحور أساسي للتقدم.
2.1.1. مسوغات العلاقة بين اللغة والتنمية:
إن علاقة اللغة بالتنمية هي حقيقة لا تحتاج توضيحا ولا تفسيرا، فهي في حد ذاتها علاقة بين اللغة والقوة، خاصة في ظل عولمة السوق واقتصاد المعرفة؛ لأن اللغة، اليوم، أصبحت تستند إلى المعرفة فتجاوزت بعدها الإيديولوجي إلى كونها إحدى أعمدة التنمية المستدامة؛ لقد أصبحت لها أهمية كبرى في النشاط الاقتصادي في العصر الراهن لتعدد مجالات استخدامها تبعا لتعدد أدوات الاتصال التجاري بين الأفراد والشعوب حتى أصبحت هي الأخرى ينظر إليها على أنها سلعة ذات قيمة تبادلية تتزايد مبيعاتها في ظل الطلب المتنامي عليها، ومن ثم أصبحت ذات قيمة سوقية تسهل تلبية حاجيات الأفراد وتوسع مجال الفعل لديهم، إذا كانت النقود وسيطا للتبادل فإن اللغة تسهل التبادل، وهذه القيمة السوقية للغة تخضع للعوامل الاقتصادية، لقد ذهب كل من ليبينتز ودايفيد هيوم ويوهان جورج هامان إلى أن اللغة ليست قيمة في حد ذاتها بل تنطوي أيضا على القيمة الاقتصادية، فاللغة اليابانية- عكس الصينية- ارتفعت قيمتها في السوق العالمية للغات الأجنبية خلال العقد الماضي، وهو تطور يشبه إلى حد كبير ارتفاع قيمة الين في سوق العملات، حيث أصبحت اليابان شريكا تجاريا مهما لعدة بلدان على مستوى القارات.[17]
وفي ظل حركية العالم أعطى المجتمع الدولي أهمية كبرى لما يسمى ب"اقتصاد المعرفة "، وذلك من خلال تقارير التنمية البشرية التي أصدرتها العديد من المحافل والمؤسسات الدولية حيث أصبح ينظر إلى المعرفة على أنها رافعة للاقتصاد نحو التنمية والانتعاش، لكن ما علاقة اللغة باقتصاد المعرفة؟ وما مدى قدرتها على حمل مشروع المعرفة نحو التنمية؟
ترتبط المعرفة بالسياسات الاقتصادية لأن تطوير الإنتاج الاقتصادي رهين بالمشاريع العلمية المعرفية التي يتم التخطيط لها، فهي تتعلق بمعرفة المعلومات المتداولة في سوق الاقتصاد، أما اللغة فهي أداة حصول هذه المعرفة ودلالة اللغة على المعرفة الاقتصادية يجعلنا أمام وظيفة جديدة للغة وهي "الوظيفة الاقتصادية" إلى جانب الوظيفة التعليمية والإعلامية والسياسة للغات داخل البلد.[18]
فالمعرفة هي القوة المُتوِّجة والموجهة للقوى الاقتصادية والسياسية والعسكرية والمالية والثقافية، تتجلى من خلال الاستثمار في الرأسمال البشري عبر توفير نظام تعليمي متين في جميع مراحله، ونظام تأهيل مبني على كفاءات متمكنة، وبناء عقول مبتكرة ومنفتحة على كل جديد ومواكِبة له، فالعنصر البشري من أهم العوامل التي تصنع التنمية ووسيلته في ذلك اللغة، فالإنسان جيد التعليم والتدريب على العلوم المعاصرة والتقنيات الحديثة والمتشبث بتراثه و ثقافته وحضارته، هو القادر على تحقيق التنمية الشاملة خاصة في ظل عالم سريع التغير يعرف طلبا متزايدا على الاستثمار في اعتماد الذكاء الاصطناعي وفي التعليم. [19]
لذلك يرى بيرجيت بروك أنه ينبغي أن يكون التعليم في قلب أجندة التنمية بسبب المساهمة التي يقدمها في العديد من المجالات التنموية، بما في ذلك التوظيف والصحة والاستدامة البيئية وبناء السلام والأمن الغذائي وأيضا تعزيز الحقوق الديمقراطية والمواطنة، ومن هذا الجانب أيضا يرى ميرسير أنه "لتحسين نتائج التعلم يجب أن يتم التركيز على دعم تطوير واستخدام لغة التدريس ومحو الأمية..."، [20] وقد ركز تقرير الأمم المتحدة عن التنمية المعرفية في العالم العربي على ضرورة العناية بالتعليم المبكر وضرورة إقامة تعليم عال وتقني باللغة العربية مع تقوية الجهد في تعليم اللغات الأجنبية حتى تحصل قدرات التملك والتفكير وتنمية القدرات الذهنية والإبداعية للفرد وإقامة جسور التداخل والتكامل بين التخصصات، وبالتالي فاللغة هي رابطة العقد في منظومة المعرفة.[21]
فالنهوض بالمجتمع يبدأ أولا بتطوير الأفراد من خلال الاستثمار في تعليم اللغة ورفع مستوى الوعي وتعزيز وسائل التعبير لديهم من أجل الانفتاح على خبرات وتجارب وعلوم الآخرين، أو بالأحرى يمكننا القول: التنمية الشاملة بوابتها التنمية اللغوية.
إذن يمكن النظر إلى هذه العلاقة السببية بين اللغة والتنمية كما يلي:[22]
اللغة رافعة من رافعات التنمية الشاملة والمستدامة.
اللغة محفز للإبداع والابتكار والنهوض متى امتلكت بالأمة الآليات لذلك.
اللغة عامل مهم لنشر المعرفة بشكل موسع مما يسهم في تشكيل مجتمع المعرفة.
اقتصاد المعرفة اقتصاد بديلٌ قوامه مجتمع المعرفة.
3.1.1.لسانيات من أجل التنمية:
إن التحدي الذي أصبح يمثله التراكم المعرفي السريع في سباق مع زمن العولمة نحو المواكبة والإنتاج يقود بشكل مستعجل إلى تهييئ لغوي موجه بشكل صريح نحو تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي في ظل التطور العلمي، الشيء الذي يضعنا أمام سؤال: كيف يمكن تأسيس لسانيات موجهة بالتحديد للقيام بهذه المهمة؟
تتفق الدراسات الحديثة على أن الخطاب العلمي لا ينشأ دائما من الفضول العلمي بل أحيانا من الضرورة الاجتماعية، ودليل ذلك حسب جراوتزgrawitz ما عرفته العلوم الاجتماعية من تطور بفعل تأثير تجربة الحرب العالمية الثانية،[23] وبالتالي فإن الحديث عن علاقة اللغة بالتنمية ينقلنا من مجال اللسانيات التقليدية، التي تعنى بدراسة اللغة على أنها نسق رمزي وظاهرة مستقلة عن السياقات الاجتماعية، الغرض من دراستها هو فهم القواعد والأنظمة اللغوية، إلى مجال اللسانيات التنموية التي تتعامل مع اللغة في سياقها الاجتماعي وتعتبرها جزءا من النسيج الثقافي وتركز بالضبط على العلاقة القائمة بين اللغة والتنمية الاجتماعية.[24]
نجد في الأدبيات ثلاثةَ منظورات تتساءل عن العلاقة بين اللسانيات والتنمية: تنمية اللغة عند الفرد ( الاكتساب اللغوي أو المستوى التطوري) تنمية اللغة في المجتمع ( التخطيط والسياسة اللغوية أو المستوى البنائي) قيمة اللغات على مستوى الموضوع أو المجموعة(اقتصاد اللغات، أو المستوى القيمي/ الإيديولوجي)، هذه المنظورات ترتبط مع بعضها البعض، حيث ترتبط قضايا اكتساب اللغة (وأيضاً التعلم وحتى فقدان اللغة) بشكل مباشر بظروف انتقالها ومكانتها في المجتمع، فمثلا لم نعد نتحدث عن انتقال اللغة من الآباء إلى الأبناء( اللغة العامية)، بل أصبحنا أمام فرض لغة مرموقة في المدرسة، كونها حاملة للمستقبل والتنمية التقنية والاقتصادية؛ كما هو الحال بالنسبة للغة الفرنسية واللغة الإنجليزية في شمال إفريقيا، حيث تشكلان إطاراً للعديد من الاختيارات الفردية والعائلية والجماعية، والتي غالباً ما تمليها رؤية نفعية للغات الطبيعية.[25] وفي السنوات الأخيرة تم إثراء هاتين اللغتين من خلال منهج جديد يطلق عليه اللسانيات التنموية أو لسانيات من أجل التنمية( الاجتماعية)، حيث يتم استخدام أدوات عالم اللغة في خدمة التنمية، ويرتبط ظهور هذا النوع من اللسانيات والذي هو فرع من اللسانيات التطبيقية بظهور ثلاث حالات طارئة والتي تتطلب بطبيعة الحال اللغة والخطاب:
ظهور مفهوم التنمية المستدامة، وبالتالي صعود الخطاب البيئي.
التنوع اللغوي وارتباط قيمته بقيم التنوع البيولوجي.
الدفاع عن الحقوق اللغوية باعتبارها حقوقا إنسانية في حد ذاتها، وهذا في إطار منظور عام يتعلق بإنهاء الاستعمار وتمكين الشعوب والأفراد وتقرير مصيرهم.
باختصار، اللسانيات من أجل التنمية هو برنامج بحث عملي يحشد الموارد اللغوية استناداً إلى تشخيصات دقيقة، لتحسين الظروف المعيشية للأفراد والمجتمعات المهمشة- وهذا التحسين هو ما يسمى ب"التنمية"- وذلك من خلال إعادة تأهيل و إحياء اللغات المحلية من أجل تعزيز الهوية الثقافية وتقوية الروابط الاجتماعية داخل هذه المجتمعات، وتطوير برامج تعليمية تتناسب مع اللغات والثقافات المحلية، مما يسهل الوصول إلى تعليم شامل، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية للأفراد وفك العزلة عن الجماعات المهمشة( الرحل والمهاجرون)، وتحليل الخطابات السياسية والإعلامية والوقوف على مدى تأثير اللغة في الوعي العام والسياسات العامة.[26]
إن الغايات التي تهدف إليها اللسانيات من أجل التنمية تجعلنا نفهم مدى حرصها على تحقيق مشروعيتها العلمية من خلال توسلها بالآليات الإجرائية التي تسمح لها بتحويل المجال الاجتماعي وتحسين ظروف عيش البشرية، إنها تظهر في سياقات اجتماعية واقتصادية تتسم بالفشل الواضح للسياسات التي تجاهلت البعد البشري في التنمية، إن هذا الفرع من اللسانيات لا يظهر إلا في تظافر اللغة والمجتمع ، لكن طموح المرحلة الراهنة لا يتلخص في إثارة إشكالية العلاقة بين اللغة والمجتمع بقدر ما يتلخص في إثبات دور الدارسين اللغويين في المشاركة في التنمية البشرية،[27] يؤيد هذا الرأي عدد من الباحثين الرائدين في هذا المجال أمثال: بوت با نجوك Bot Ba Njock توماس بيرث Bearth thomasبيبان تشومبو Beban Chumbow ديكي كيديري Diki-Kidiri وتادادجوTadadjeu, وتورنوكس Tourneux وسيلاSylla (المؤسس المشارك للجمعية الإفريقية للتعليم والتدريب من أجل التنمية) SAFEFOD)) من بين آخرين، واعترافهم بمدى مساهمة البحث اللساني في تنفيذ استراتيجيات لصالح التنمية،[28] نلاحظ إذن أن المساهمات البحثية تأتي من العقول الإفريقية، لذلك ليس من الغريب أن تكون مجلة"Jeynitaare" مجلة إفريقية خاصة باللسانيات من أجل التنمية، وأن تكون الشبكة الدولية "POCLANDE " ( السكان والثقافة و اللغات والتنمية) قد تأسست كتجمع علمي في عام (2018) في أكرا (غانا) خلال مؤتمر دولي لعلم اللسانيات إفريقية، وبفضل هذه الشبكة تكتسب اللسانيات من أجل التنمية بعدها الدولي بشكل متزايد وتتشكل بما يتماشى مع المجالات التي تعمل فيها خاصة: بأمريكا اللاتينية و الشمالية( من خلال البحث في اللهجات)، والنموذج الكندي( الحقوق والواجبات اللغوية) و حتى أوروبا الوسطى والجزر ذات الأقليات بها،[29]وتظهر أهمية هذا الفرع من اللسانيات من خلال الاختيار المتكرر لهذا الموضوع في سياق العديد ما الأحداث والمحافل الدولية، أذكر منها:[30]
الدفاع عن اللسانيات التنموية كجزء من برنامج عمل لتوجيه البحث في جامعة سوربونSorbonne( 2009).
نشر عمل تورنوكس(اللغات والثقافة والتنمية في إفريقيا)(2008).
اختيار موضوع اللغة والتنمية كمشروع بالجامعة الأكاديمية في الكامرون التي نظمتها وزارة التعليم العالي في ياوندي(2007).
إطلاق مشروع LAGSUS(اللغة LanguageوالجنسGender والاستدامة Sustainability ) في ساحل العاج(2003).
انعقاد المؤتمر الدولي 23 للمنظمة الإفريقية للغات حول موضوع اللسانيات الإفريقية أداة لتنمية المجتمعات الإفريقية(2002).
إنشاء الجمعية الإفريقية للتعليم والتدريب SAFEFOD من أجل التنمية في داكار(1991).
إنشاء قسم اللغة والتنمية في LLACAN(المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي CNRS) باريس.
إنشاء برنامج اللغة والتنمية من قبل الوكالة الجامعية للفرونكفونية AUF.
ترويج مفهوم التواصل من أجل التنمية من قبل هيئات المنظمات الدولية UNICEF, UNESCO وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيPNUD... سعيا لدمج هذا المفهوم في جميع مكونات الاتصال الاجتماعي....
وأيضا من خلال الاهتمام الذي توليه بعض الجامعات به، حيث تقدم برامج تدمج عناصر من اللسانيات من أجل التنمية الاجتماعية (LDS)، رغم أن هذا المجال لا يذكر دائما باسمه المحدد. فيما يلي بعض الأمثلة البارزة:[31]
1. جامعة بوردو مونتين (فرنسا)
- ماجستير "التعدد اللغوي واللسانيات من أجل التنمية الاجتماعية"
يقدم هذا البرنامج تكوينا في قضايا التعدد اللغوي وتفاعل اللغات، مع التركيز على الجوانب النظرية والتطبيقية المتعلقة بالتنمية الاجتماعية.
- شهادة مزدوجة بين جامعة بوردو فرنسا) وجامعة كونستانز (ألمانيا )
يتيح هذا البرنامج فرصة الدراسة في جامعة كونستانز، مما يمنحه بُعدا دوليا.
2. جامعة باريس سيتي ( Université Paris Cité)
- مدرسة الدراسات العليا في اللسانيات
تجمع هذه المدرسة بين عدة برامج ماجستير متخصصة في علم الاجتماع اللغوي وتحليل الخطاب، وهي مجالات وثيقة الصلة بـ LDS.
https://u-paris.fr/graduate-schools/linguistics-graduate-school/
- ماجستير في علوم اللغة - تخصص: علم الاجتماع اللغوي وتحليل الخطاب
يوفر هذا التخصص تكوينا متقدما في علم الاجتماع اللغوي، مما يسمح باكتساب مهارات قابلة للتطبيق في التنمية الاجتماعية.
3. جامعة جان مولان ليون 3 (فرنسا)
- ماجستير في اللسانيات والدراسات اللهجية
يوفر هذا البرنامج تكوينا معمقا في اللسانيات العامة واللهجيات، مع التركيز على مجالات مثل علم الاجتماع اللغوي، وهو مجال مرتبط بالـ LDS.
https://facdeslangues.univ-lyon3.fr/master-linguistique-et-dialectologie
الملاحظ أن اللسانيات من أجل التنمية الاجتماعية (LDS) لا تزال مجالا ناشئا، وبالتالي فإن البرامج الجامعية المتخصصة فيه نادرة حاليا. ومع ذلك، توفر العديد من الجامعات مقررات أو تخصصات في علم الاجتماع اللغوي، التعدد اللغوي، وتحليل الخطاب، وهي موضوعات قريبة جدا من LDS .
نجد من جانب آخر أن اللسانيات من أجل التنمية تستعير مفاهيمها من حقول معرفية ولسانية عدة، على سبيل المثال، نجد أن مفهوم الهوية له أصول في علم النفس، لكن إضفاء البعد اللغوي في مركز هوية الفرد يجعل منه مفهوما مألوفا في هذا المجال،[32] كما يميل التوجه العام للبحث في هذا الفرع من اللسانيات في تقاطعه مع اللسانيات الاجتماعية نحو التَّكرار من خلال تناوله مواضيع من قبيل: تخطيط اللغة[33] من أجل التنمية، والتخطيط المصطلحي والصرف تركيبي، والتخطيط الثقافي، والترجمة، والبحث في اللغات العابرة للحدود...إلخ، [34]غير أن ما تسعى إليه اللسانيات الاجتماعية عبر سياسة التخطيط هو تنظيم وإدارة اللغات في مجتمعات التعددية اللغوية، بينما تسعى اللسانيات التنموية إلى استخدام اللغة كأداة للتغيير الاجتماعي في البلدان المهمشة، خاصة تلك التي كانت مستعمرة سابقا والموجودة شمال إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، والتي تحارب من أجل تجاوز التحديات التي تواجهها للهروب من الفقر،[35] هنا سنجد أنفسنا بين مفهومين متداخلين:" تنمية اللغة" و" لغة التنمية"، فلكي تعمل اللغة كرافعة للتنمية يجب أن تكون أولا وظيفية وقابلة للاستخدام، فإذا أردنا استخدام تنوع لغوي معين لتحسين مستوى التماسك الاجتماعي لمجتمع ما، ينبغي أولا توثيقُ هذا التنوع وتوحيدُه علميا في كل من الشكل الشفهي والمكتوب، ولا يتم ذلك إلا من خلال التخطيط للغة وقدرتها على أن تكون متداولة في الفضاء العام،[36]وهذا يضعنا أمام التساؤل من جديد عن ماهية العملة اللغوية التي يمكنها المساهمة في تحقيق التنمية، هل هي اللغة العالمة أم اللغة الأم أم هما معا؟
خلاصة:
لم يأت الوقوف على اللغة على أنها استجابة آنية ومستقبلية للحاجة التنموية داخل المجتمع، عبثا؛ بل هو نتاج الوعي بقيمتها و بأنها الوسيلة الأنجع والسبيل الصحيح نحو التغيير، وأيضا بعد استيعاب مدى الخطر الذي قد تسببه الخلافات اللغوية داخل المجتمعات، ففهم تأثير اللغة على الأفراد والمجتمع عبر الأجيال موضوع يستحق البحث والدراسة العميقة، خاصة في ظل التحولات الثقافية والسياسية التي يشهدها العالم، إذ إن اللغة ليست وسيلة للتواصل فقط؛ بل هي نظام معقد يؤثر في الهوية الوطنية والسياسة التعليمية والاستراتيجيات اللغوية داخل الدول والتنمية المستدامة، إن السعي نحو العمل على اللغة كمجال استراتيجي ذي أولوية يؤثر على مختلف الميادين، هو ما جعل الدراسين اللغويين يعيدون التفكير في طرق استثمار الدراسات اللغوية وفي سبل جعل البحث اللساني مفتاحا لتقدم الأوطان وتعزيز مكانة اللغة عالميا.
***
الطالبة الباحثة: زينون غزلان
ماستر تحليل الخطاب وقيم التنمية
........................
لائحة المراجع العربية
ابن فارس (2008)، ج2، مقاييس اللغة، باب النون والميم وما يثلثهما، تحقيق ابراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية.
حليلي عبد العزيز (1991) اللسانيات العامة واللسانيات العربية: تعاريف – أصوات، منشورات دراسات (سال)، الطبعة الأولى
فلوح أحمد، (2020) اللغة والتعليم والتنمية، مجلة السراج في التربية وقضايا المجتمع، العدد 1.
غلفان، مصطفى ( 2010) في اللسانيات العامة، تاريخها، طبيعتها، موضوعها، مفاهيمها، دار الكتاب الجديدة المتحدة، الطبعة الأولى.
كولماس فلوريان،(2000)، اللغة والاقتصاد، ترجمة: أحمد عوض، مراجعة: عبد السلام رضوان، سلسلة عالم المعرفة.
المحمود محمود بن عبد الله(2018) التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية، تأصيل نظري، مركز التخطيط والسياسة اللغوية، العدد 6.
المقالات الالكترونية:
إدريس مقبول، اللغة العربية من سؤال الهوية إلى رهان التنمية، رابطة أدباء الشام http://www.odabasham.net
بودرع عبد الرحمان، اللغة العربية والمعرفة في سياق التنمية البشرية والاقتصادية، الرابطة المحمدية للعلماء https://www.arrabita.ma/blog
القصباوي مصطفى، مفهوم التنمية، تعدد المقاربات، التقسيمات الكبرى للعالم خريطة التنمية، موقع الشاوني التربوي http://www.histgeo.net
التنمية البشرية مفهومها، أهدافها، مقوماتها، ومعوقاتها، الشبكة العربية للتميز والاستدامة. https://sustainability-excellence.com
الأداء اللغوي والتنمية المستدامة في عصر المعرفة، اقتصاديو العرب https://economistsarab.com
المندوبية السامية للتخطيط، المديرية الجهوية لسوس ماسة، غشت 2021، أهداف التنمية المستدامة، قراءة في منهجية الإعداد والأجرأة. https://www.hcp.ma/region-agadir
عن الإعلان العالمي حول علاقة البيئة بالتنمية، قمة ريو (1992) خلال مؤتمر الأمم المتحدة
المعني بالبيئة والتنمية https://www.mdpi.com
اليحياوي إيمان، مفهوم التنمية الشاملة، موقع موضوع https://mawdoo3.com
لائحة المراجع الأجنبية
Ayo, Bamgbose,The language factor in development goals, Language Rich africa policy dialogue, university of lbadan Nigeria, The Cape Town Language and Development Conference:
Birgit Brock-utne, Language as a contributor to post-MDG development perspectives in Africa, Language Rich Africa policy dialogue, university of lbadan Nigeria, The Cape Town Language and Development Conference: Looking beyond 2015,
British council.
Giovanni Agresti (2024), Une linguistique pour le développement social, HAL open science.
Laurain, Assipolo, La monnaie linguistique : une solution pour le développement de l’Afrique ? Université de Yaoundé.
Léonie, Métangmo-tatou, (2019), Pour une Linguistique du développement, Essai d’épistémologie sur l’émergence d’un nouveau paradigme en sciences du langage, éditions science et bien commun, avenue de Bourlamaque, Québec (Québec) G1R 2P4 Looking beyond 2015, British council.
Plurilinguisme et linguistique du développement social, université Bordeaux montaigne. https://formations.u-bordeaux-montaigne
[1] غلفان مصطفى (2010) ص: 12
[2] حليلي (1991) ص: 11
[3] نفسه، ص: 11
[4] نفسه، ص: 194
[5] ابن فارس، مقاييس اللغة، ج 2، باب النون والميم وما يثلثهما.
[6] Ayo, Bamgbose, The language factor in development goals, Language Rich africa, p 98
[7] Léonie Métangmo-tatou,(2019) P 39
[8] القصباوي مصطفى، مفهوم التنمية http://www.histgeo.net
[9] نفسه.
[10] مقبول إدريس، اللغة العربية من سؤال الهوية إلى رهان التنمية، http://www.odabasham.net
[11] مفهوم التنمية الشاملة https://mawdoo3.com/
[12] المندوبية السامية للتخطيط، ص 4
[13] نفسه، ص 4
[14] نفسه، ص 7
[15] عن الإعلان العالمي حول علاقة البيئة بالتنمية، قمة ريو https://www.mdpi.com
[16] التنمية البشرية مفهومها، أهدافها، مقوماتها، ومعوقاتها https://sustainability-excellence.com
[17] كولماس فلوريان،(2000) ص: 9
[18] بودرع عبد الرحمان، اللغة العربية والمعرفة في سياق التنمية البشرية https://www.arrabita.ma/blog
[19] الأداء اللغوي والتنمية المستدامة في عصر المعرفة https://economistsarab.com
[20] Birgit Brock-utne, Language as a contributor to post-MDG development perspectives in Africa, Language Rich Africa, P 114-115
[21] بودرع عبد الرحمان، اللغة العربية والمعرفة في سياق التنمية البشرية والاقتصادية https://ww>> يلا بانw.arrabita.ma/blog
[23] Léonie Métangmo-tatou, (2019) p 39
[25] Plurilinguisme et linguistique du développement social, université Bordeaux montaigne
[26] Giovanni Agresti(2024) pp 5-6-10
[27]Léonie Métangmo-tatou,(2019) p 39
[29] Plurilinguisme et linguistique du développement social, université Bordeaux montaigne
[30] Léonie Métangmo-tatou,(2019) p 46-47
[31] منقول عن الدكتور الساحلي عادل، أستاذ وحدة اللسانيات التنموية، ماستر تحليل الخطاب وقيم التنمية.
[32] Léonie Métangmo-tatou,(2019) p 55
[36] Giovanni Agresti (2024), p 3